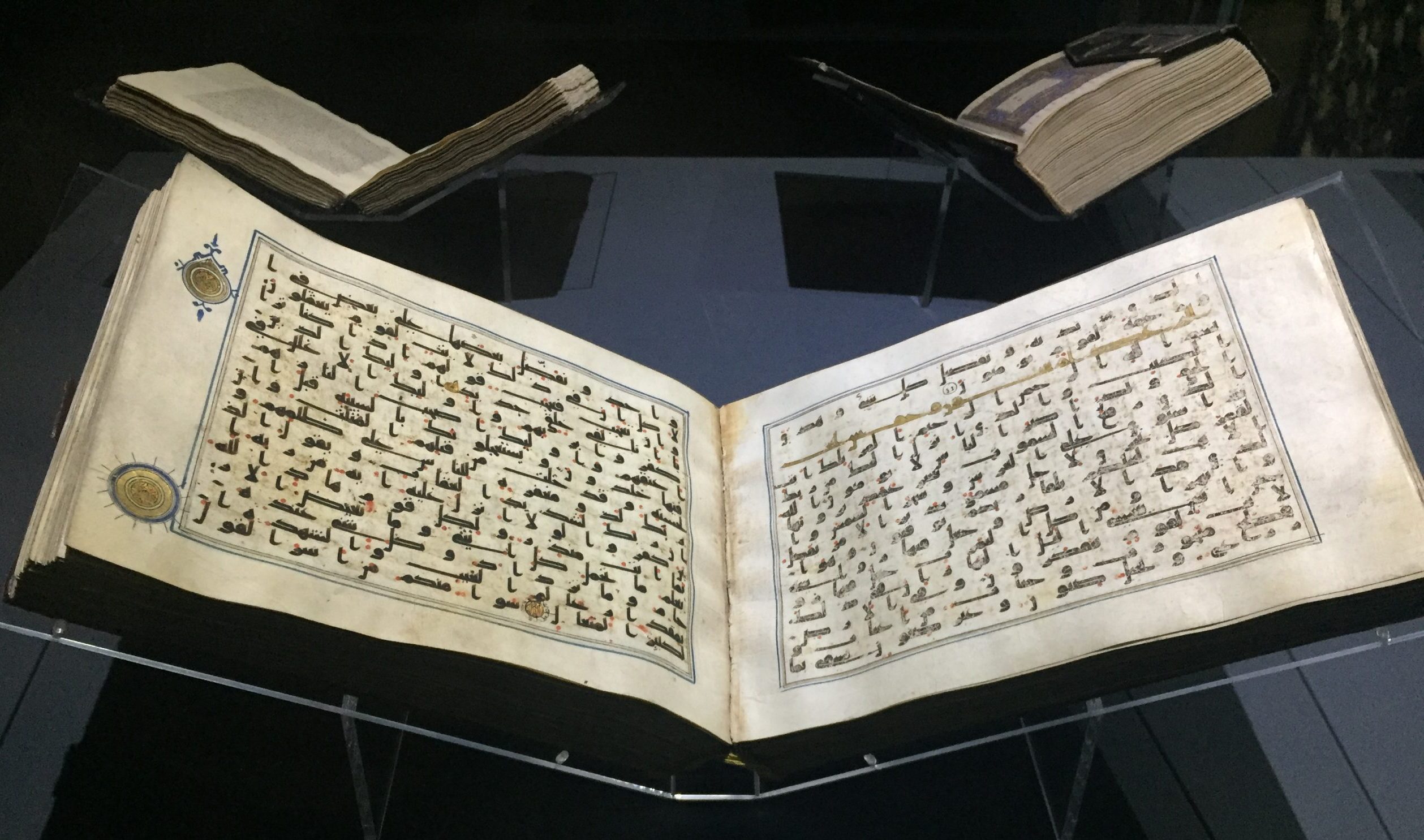هذه خطة بحث باعتقادي مهمة وجديرة بالوقوف عليها مطولاً، لم يكتب الله لي العمل عليها وإتمامها، أضعها على مدونتي علّها تُسهم في مساعدة متواضعة لطلبة العلم والباحثين في المناهج العلمية في توجيه خططهم البحثية.
يُعد التفكير النقدي أعلى أشكال التفكير التأملي والمعقول حيث يقوم العقل من خلاله بعمليات التعليل والسببية والحجاج والمناقشة والتحليل والتركيب والبرهنة والاستقراء والاستنباط والاستنتاج وجمع الأدلة واستبعاد أخرى… سعياً لحل المشكلات أو للتحقق من ظاهرة علمية أو اجتماعية أو معرفية ما، أو من جزء منها أو من مصدرها وأصلها ومصداقيتها، وذلك للوصول إلى قرار أو حكم حول ما نصدقه أو نؤمن به أو نقوم به.
وقد شغلت منهجية التفكير النقدي مكانة مهمة ضمن المناهج التربوية المعاصرة على اعتبارها من ضرورات امتلاك مهارات التفكير المختلفة سعياً لتمكين الإنسان القدرة على الحكم الصحيح على دقة وصحة المعلومات المتدفقة بشكل هائل وَبسمة فوضوية في غالبها في عصرنا الحالي.
وإن جئنا إلى بعض التعريفات عن التفكير النقدي من الكتب الغربية المترجمة نجد مثلاً تعريف إدوارد كليسر Edward Glaser يقول فيه هو: “الميل إلى التفكير العميق في المشاكل والمواضيع التي ترد ضمن مجال خبرة المرء”. وإنه “يدعو إلى بذل جهد مستمر لتفحص أي اعتقاد أو أي شكل مفترض من المعرفة في ضوء الدليل الذي يدعم ذلك الاعتقاد واستنتاجات أخرى تنتج عنه”. (ألِك فِشَر، التفكير الناقد، ص 16). ونسأل هنا ما هو هذا الاعتقاد أو المعرفة المقصودة في هذا التعريف؟ هل هي عقيدته الدينية على سبيل المثال أم أن الاعتقاد هنا هو ما يؤمن به المرء ويتبناه من آراء وتوجهات بشكل عام؛ ذلك أن الكلمة نفسها “الاعتقاد” تختلف دلالتها في السياق الغربي عنه في السياق الإسلامي. عدا عن إشكال إمكانية الفصل بين العقائد وبين الرؤى المتبناة حول الوجود. ويظهر هنا إشكال منهاجي مهم بخصوص هذا التعريف ‑وغيره‑ كون المسلم لا يخضع عقيدته أو ثوابته إلى الفحص والتدقيق والتقليب والنقد؛ بالتالي نقع في فخ اللغة والسياق والدلالات.
ويقول ريتشارد بول Richard Paul إن التفكير الناقد هو “التفكير في أي موضوع أو محتوى أو مشكلة حيث يحسن المفكر نوع تفكيره بعنايته الماهرة ببنية التفكير الموروث ويطبق معايير عقلية عليه”. (التفكير الناقد، 18). تُرى هل المعايير العقلية تلك يمكن أن تكون واحدة كلية شاملة؟ وهل التفكير بالموروث يتضمن التفكير بالموروث القادم من الثقافة الغربية على سبيل المثال؟ وهل بالإمكان فصل عمل منهج التفكير النقدي عن المبادئ والقيم الكبرى في الإسلام؟
إن لكل نسق حضاري وثقافي مناهجه المعرفية والقيمية، ولكل أمة منطلقاتها الفكرية المرتكزة إلى عقيدتها وثقافتها، وتاريخها الغني بإرث من المواقف والنقاشات العقلية التي تشكل بناءً فكرياً خاصاً يحمل فيه محاكمات عقلية والعديد من الأنماط التطبيقية للتفكير الإبداعي والنقدي والتحليلي في سعيه لاتخاذ القرار الصائب في التقويم والنقد. قال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} [المائدة: 48].
ومن الصحيح أننا قد نجد العديد من المشتركات بين منهجية بعض العلوم الإسلامية العلمية والنقدية من الناحية المنطقية في الحكم والاستنتاج وبين موضوع التفكير الناقد في الدراسات المعاصرة أو القديمة، إلا أنه لا بد من الانتباه إلى أن الكثير من الخصوصيات في منهجيات التفكير النقدي في العلوم الإسلامية تتفرد بها عن مثيلاتها في العلوم الغربية، من بين تلك الخصوصيات، الإطار المرجعي والمصدري للجانب العقلي من عملية المعرفة.
فالإنسان الغربي مثلاً عندما يريد أن يمارس التفكير النقدي في عملية المعرفة ينطلق من فرض بعض الفروض ثم يتأمل ويقلب كل فرض على حدة، ثم يستبعد ويضيف إلى أن يصل إلى استنتاج يطمئن له عقله. أما عقل المسلم فإنه ينطلق أولاً من المصدر المعرفي الأول لديه؛ القرآن والسنة وما استند إليهما من طرق الإجماع والقياس، ثم يأخذ بالتفكير في قضايا الوجود والإنسان في ضوء هذه المصادر تدبراً وتأملاً.
الاختلاف الجوهري هنا يكمن في أن المعرفة عند الغرب هي كل ما هو معلوم وفي دائرة الحس والتجربة، بينما المعرفة في الإسلام هي المعلوم الذي دلّ عليه القرآن الكريم والسنة النبوية أولاً ثم دل عليه الحس والعقل والتجربة بهدي من القرآن والسنة.
وإن جئنا إلى تقييم مصداقية المصادر من خلال منهجية التفكير النقدي في المؤلفات الغربية؛ تُرى هل المعايير التي يجب نشدانها في المصدر الذي نود الحكم على مصداقيته هي نفسها معاييرنا الإسلامية؛ بمعنى هل محددات الثقة والانحياز وامتلاك القدرة على الملاحظة الصحيحة من رؤية وسماع وأدوات مناسبة هي نفسها تنسحب على الثقافات كلها؟
إن تراثنا العلمي غنيٌّ بالمناهج العلمية النقدية؛ منهجية نقد الرجال في علم الجرح والتعديل الحديثي، ذلك العلم الذي تفوق في منهجيته النقدية على سائر منهجيات العلوم الإنسانية في توخيه التحقق الناقد الدقيق من نسبة نص ما إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الجهود الكبيرة التي بذلها العلماء المسلمون في وضع قواعد عقلية لاستقراء الجزئيات واستنباط الأحكام الشرعية منها في علم أصول الفقه حيث نجد أدق المناهج العلمية النقدية في التعامل مع النص وتحديد علاقة النص بالواقع، ناهيك عن العديد من المؤلفات حول آداب المناظرة والجدل والمناقشة وآلياتها وشروطها العلمية الدقيقة. فكما وضع المفكرون الغربيون مبادئهم النقدية ومناهجهم، وضع العلماء المسلمون في مسيرتهم العلمية الطويلة مقدمات ومبادئ للتفكير العقلي النقدي. وقد مارسوا بأنفسهم التفكير النقدي بكل وضوح واعتمدوه منهجية دقيقة في تحليلهم وتفنيدهم لظاهرة ما أو لمناقشاتهم فيما بينهم والمبثوثة في مؤلفاتهم. فأبو حامد الغزالي مثلاً يتعرض في كتابيه “مقاصد الفلاسفة” و” تهافت الفلاسفة” إلى الكثير من الآراء والبراهين بدقة ومنهجية عالية. وابن الجوزي في كتابيه “تلبيس إبليس” و “ذم الهوى” يظهر مدى سعة عقله في بناء منهجه النقدي للمظاهر الاجتماعية والفرق الدينية وبعض علماء عصره بشكل واضح. وابن تيمية المشهور في نقده لمنطق أرسطو أسس لمناهج نقدية مؤصلة إسلامياً تستند إلى القرآن والسنة الشريفة في كتابه “در تعارض العقل والنقل”.
وطالما أن غاية عمل التفكير النقدي هي رفض الاستلاب والتبعية والتحري الدائم لإعلاء قيم العدل والحق والفضائل الأخلاقية، فالأولى عندما ننادي بنهضة حضارية تشمل العلوم والفنون والعمران في العالم الإسلامي الوقوف بدءاً على مناهج البحث وأساليب التفكير ومصادر العلوم ومناهجها نفسها التي تُبنى عليها تلك العلوم.
ومن جهة ثانية، فإن التعليم في المؤسسات التعليمية والتربوية دون إعمال العقل النقدي والإبداعي جهدٌ ضائعٌ يقتصر على تخريج عقول مسلوبة مقلدة معطلة، وبات من المعلوم أن المناهج المتبعة في تلك المؤسسات تبنت مناهج غربية خاصة في العلوم الإنسانية كعلم النفس والاجتماع والسياسة… دون الإشارة إلى الأسس الفلسفية العلمانية لهذه المناهج ما تبدو وكأنها مسلمات بدهية عامة تنطبق على العقول البشرية كلها مهما اختلفت مرجعياتهم الثقافية والعقدية، وما هذا إلا عملية تصبّ في ترويض العقل المسلم ضمن قوالب منهجية غربية الأصل، وجعله “إمعة” يتبع عقول الآخرين ونتاجاتهم وينقاد انقياداً أعمى وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك: “لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا”. (رواه الترمذي، حديث رقم 2007).
ولشدة الهجمة الاستخرابية الفكرية الغربية فإننا بأمس الحاجة؛ أولاً: إلى إعادة البحث في تراثنا الإسلامي واستخراج الكنوز العلمية والمنهجية منه كي نرسم معالم طريق الخريطة المعرفية الإسلامية للمسلمين وإعادتها إلى صدارة المشهد العلمي من حيث المنهج والنظريات والفرضيات والأمثلة والسلوكات ينظمها مبدأ التوحيد، ومقاصد الأمانة والاستخلاف والإعمار. وثانياً: إلى أيّ جهد لتعريف المسلم على أكبر قدر من العلوم الإسلامية ومنهجياتها العلمية وفقاً للتكامل المعرفي بين العلوم الإنسانية والعلوم الشرعية التي يجب تبنيها من قبل الباحثين والعاملين في السلك التعليمي والدعوي، بعيداً عن مناهج التفكير العلمانية الغربية ومختلفة عن الكتب التخصصية الخاصة بفئة قليلة من الباحثين.
مشكلة البحث
على الرغم من الانتشار الواسع للدراسات والمؤلفات التي تناولت موضوع التفكير النقدي وأهميته في عملية تطوير الفكر الإنساني وانعكاسه على حياته، إلا أننا نكاد لا نعثر على مثل هذا الانتشار للدراسات وفقاً للمنهجية الإسلامية، ناهيك عن العزوف عن التأليف في هذا الفن من العلوم مراجعة وتطويراً؛ فيطغى أغلبها على نظريات الغرب وفلسفاته عن التفكير الناقد ويتم تداولها في الأوساط الفكرية والعلمية المسلمة ترجمة وتدريساً وبحثاً وتقليداً.
وعليه من الممكن تحديد مشكلة البحث من خلال الأسئلة الآتية:
- كيف حثّ القرآن الكريم والسنة النبوية على إعمال العقل والنقد؟
- ما مدى أهمية التفكير النقدي في منهجية علوم الأمة الإسلامية؟
- كيف وصلت الأمة إلى حالة مستعصية من التبعية المنهجية والتغريب الفكري والاستلاب القيمي؟
- ما حدود اشتراك قواعد التفكير النقدي في العلوم الإسلامية مع مهارات التفكير النقدي بشكل عام؟
- ما الأثر الذي خلّفه فصل العلوم الإنسانية عن العلوم الشرعية وكيف السبيل إلى سدّ الفجوة بينها؟
- كيف نستفيد من التفكير النقدي المنهجي الإسلامي ونعيد تفعيله وتطويره في مستويات الحياة كافة؟
محددات البحث
سيتناول البحث مفهوم التفكير النقدي وتأصيله في القرآن والسنة النبوية، وسيحاول إبراز بعض أهم المناهج التي استند إليها العلماء المسلمون في مسيرتهم العلمية الثرية والتفصيل فيها بالوقوف على تعريفاتها والأمثلة عليها من القرآن والسنة وآلية عملها ومضامينها انتهاءً بالتطبيقات العملية الحياتية، وذلك من خلال رحلة التنقيب عن مناهج التفكير النقدي تحديداً في علوم المسلمين المنطقية والأصولية والكلامية والحديثية والتاريخية متجاوزة الاختلافات والخلافات بين العلماء والتي قد تعترض البحث حول هذا الموضوع. كما لن يتطرق البحث إلى عقد مقارنات أو مقابلات بين منهجية التفكير النقدي وأدواتها من العمليات الاستقرائية والاستنباطية وبناء الحجج وغيرها عند العلماء المسلمين ومثيلاتها في الفكر الغربي إلا فيما يتعلق بتبيان المظاهر العامة المفارقة لمنهاجية كل منهما.
أهمية البحث
تكمن أهمية هذا البحث في أنه يحاول:
- إبراز مسألة من مسائل التأصيل الإسلامي لمناهج التفكير النقدي.
- إثراء الأبحاث حول موضوع التفكير النقدي لدى العلماء المسلمين.
- اعتماد مناهج العلوم الإسلامية والرجوع إلى اجتهادات علماء المسلمين في العلوم العقلية والنقدية في التأمل والفحص والتحليل والنقد والتثبت والتوثيق والتضعيف.
- ضرورة تفعيل التفكير النقدي على أسس إسلامية في حياة المسلم المعرفية والسلوكية بكافة مجالاتها.
- إظهار تميز المناهج الإسلامية وغناها وقدرتها على بناء منهجية عقلية نقدية متوازنة ودقيقة تشكل نموذجاً إنسانياً عالمياً.
- إن التركيز على مناهج العلوم الإسلامية كمصادر معرفية للتفكير النقدي كأصول الفقه أو منهجية نقد الرجال في علم الحديث أو منهج المناظرات… يساعد على تيسير فهمها وتقريبها لعقل المسلم ليتعرف على فنٍّ من العلوم الإسلامية الدقيقة ويغدو متآلفاً معها ومستغنياً عن ما خالف الإسلام من مناهج وعلوم غربية.
سبب اختيار البحث
لا نبالغ حين نقول إننا امتلأنا بالمعلومات الكاذبة والأفكار المشوهة لأصول ديننا، وغرقنا بنقل الكثير من المناهج الفكرية العلمانية الغريبة عن شريعتنا وطبقناها على مستويات حياتنا النظرية والعملية وتعاملنا معها وجدانياً دون إعمال العقل فيها والوقوف عليها، حتى عاثت الأفكار الغربية في عقولنا فساداً وعصفت في عقلانيتنا رياح الجهل والتغريب وتغلغلت منظومة قيم وأخلاق بعيدة عن إسلامنا وقيمه، ووصل التفريط من قِبلنا أن ننقل ونكتب “عن الفاسق في فعله المذموم في مذهبه، وعن المبتدع في دينه المقطوع على فساد اعتقاده…”، كما قال الخطيب البغدادي.
ما دفعني للنظر والبحث في أصل المشكلة وجذورها وخطرها على الأمة المسلمة ومنهجيتها في التفكير بشكل عام، والتفكير النقدي بشكل خاص.
- ما ذكرته من أهمية البحث شكّل لي الدافع في اختيار الموضوع والتعمق فيه.
- بدء انتشار واسع لدورات وورش تدعو لتفعيل منهجية التفكير النقدي وتعلم مهاراته من خلال منهجية تستند إلى أسس فلسفية علمانية، وقد كنتُ ممن حضر إحدى تلك الورش وأدركتُ خطر ما نحن فيه.
- منهجية إقصاء الدين من العلوم الاجتماعية والإنسانية والتي طالت منهجيات التفكير وآلياته غدت أبعد ما تكون عن حقيقة التكليف الإلهي للمسلم لإعلاء مبدأ التوحيد وفق مقاصد العبادة والاستخلاف والإعمار.
- نحن اليوم في أمس الحاجة إلى العمل على تفعيل المعرفة التكاملية للثقافة الإسلامية وعلومها ومنهجياتها تحت ضابط القيم والأخلاق الإسلامية في انعكاساتها على الواقع.
أدبيات البحث (جهود سابقة)
ظهر للباحثة ‑بحدود اطلاعها‑ وجود أبحاث على صلة بهذا البحث قد تتقاطع أو تتداخل مع جزء من الموضوع المبحوث؛ فنجد هناك دراسة عن منهج النقد الحديثي، أو منهج النقد التاريخي بشيء من التفصيل والاختصاص الموضوعي والمنهجي. كما أن هناك الكثير من المؤلفات الاختصاصية بحثت في المناهج العلمية للمسلمين بشكل عام دون الوقوف على أدوات هذه المناهج وطرق تفعيل التفكير النقدي منها بشكل خاص لجعلها ممارسة عملية.
مع وجود بعض الدراسات تناولت التفكير الناقد في مناهج التربية الإسلامية في المدارس والتي تفاوتت تغطيتها للمناهج العلمية للتفكير الناقد؛ فتراوح القصور فيها بين قصور في الموضوع وقصور في المنهج. وقد تكون أقرب تلك الدارسات والأبحاث المتقاطعة مع بحثنا هذا دراسة “التفكير الناقد من منظور التربية الإسلامية (مع حقيبة تدريبية لتنمية مهاراته لدى معلمي المرحلة الثانوية)”، إعداد: عمر الراشدي، وهي رسالة أُعدت لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 1426-1427. الرسالة بحثت في مفهوم التفكير الناقد وحددت أسسه وضوابطه وأساليبه ومعوقاته بمنظور التربية الإسلامية وانتهت إلى إعداد حقيبة تدريبية لتنمية مهارات التفكير الناقد للمعلمين مدعمة بالشواهد من الكتاب والسنة. إلا أنها تختلف عن بحثنا من حيث المنهج والشكل والشمول.
إن المشهد الفكري العقلاني الإسلامي لازال يعاني قصوراً واضحاً من حيث تغطية منهجية التفكير النقدي بشكل عام عند العلماء المسلمين، ومن حيث إعلاء هذه المنهجية تطبيقاً وإبعاداً للمناهج الغربية المتبناة.
وعليه سيضيف البحث المقترح في هذا المجال شيئاً جديداً في مجال العلوم الإنسانية، والإضافة بشكل عام إما أن تكون أسلوباً ومنهجاً جديداً له خصائصه، أو أن البحث نفسه يحوي معلومات جديدة ويتوسع في أخرى، أو أنه سينتهي إلى تأكيد بعض نتائج الدراسات السابقة أو نقضها. لذلك فالبحث المقترح سيخوض في النقاط التالية لتحقيق أهدافه:
- ففي الأدبيات الغربية والعربية عادة ما يتم إرجاع نشوء مصطلح التفكير النقدي إلى أوائل القرن العشرين، ولم يُروّج له ضمن الأوساط الأكاديمية والتعليمية في عالمنا الإسلامي إلا قريباً، وما يرمي هذا البحث إلى إثباته أن التراث الإسلامي بمضامينه وتطبيقاته حضرت فيه منهجية التفكير النقدي بكثافة وفي الاختصاصات العلمية والبحثية كافة، ما يدل على شمول الإسلام لميادين المعرفة العلمية وتكامل هذه الميادين بعضها ببعض.
- الأسس الفلسفية العلمانية التي تقوم عليها مناهج العلوم الإنسانية ومن ورائها مناهج أدلة العقول والتفكير النقدي تجعل من كل شيء في متناول النقد والنسبية واللاثبات في القيم، وهو ما يتنافى مع قيم الإسلام التي تطلب من كل مسلم مكلف قول كلمة الحق وإعلاء قيمة العدل؛ حيث يسعى هذا البحث إلى التأكيد على ضرورة تأسيس منهجية التفكير النقدي على ضوابط الإسلام وأخلاقياته.
- هذا البحث، خلافاً لغيره من الأبحاث، سيتناول جميع أشكال التفكير النقدي وجوانبه في العلوم الإسلامية المبثوثة في المصادر، مؤصلاً تأصيلاً شرعياً وفق مصادر المعرفة الإسلامية.
- أخيراً، يسعى هذا البحث من خلال المادة العلمية المجموعة إنشاء خريطة معرفية عن منهجية التفكير النقدي مرفقة بأمثلة تطبيقية بأسلوب سهل سلس بعيداً عن المجال الاختصاصي الجاف لتقريب العقل المسلم من إرثه الإسلامي في التفكير النقدي عبر شروحات وأمثلة تحاكي حياته اليومية.
منهج البحث
في ضوء المنهج الوصفي الاستنباطي والاستقرائي في هذا البحث ستحاول الباحثة:
- الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية لاستنباط مناهج إعمال العقل بشكل عام والنقدي بشكل خاص.
- استقراء آراء علماء المسلمين الأوائل وإسهامهم في موضوع التفكير النقدي.
- جمع الشواهد من أقوال ومواقف العلماء في المؤلفات الإسلامية المتعلقة بمنهجية العلوم الإسلامية وتحليل مضمونها النقدي.
- استنباط الخريطة المعرفية للمنهجية العلمية ومنهجية التفكير النقدي منها.
- الاستفادة من المادة العلمية المبحوث فيها وإنزالها على أمثلة وشواهد تطبيقية تهمّ المسلم في سلوكه.
خطة البحث
الفصل التمهيدي: المدخل إلى التفكير النقدي
المبحث الأول: مقدمة في التفكير النقدي في المناهج الغربية
المطلب الأول: النشأة
المطلب الثاني: التعريفات والمذاهب
المطلب الثالث: الأسس الفلسفية للتفكير النقدي
المبحث الثاني: طرق المعرفة الإنسانية
المطلب الأول: الحس
المطلب الثاني: العقل
المطلب الثالث: الحدس
المطلب الرابع: الخبر أو الوحي
المبحث الثالث: أنواع التفكير الأساسية
المطلب الأول: مستويات التفكير العامة
المطلب الثاني: التفكير الأدائي الخلاق
المطلب الثالث: التفكير الأدائي النقدي
المبحث الرابع: التعريف بمنهجية التفكير النقدي
المطلب الأول: المنهج، لغة واصطلاحاً
المطلب الثاني: العقل والتفكير، لغة واصطلاحاً
المطلب الثالث: النقد، لغة واصطلاحاً
المطلب الرابع: تأصيل التفكير النقدي في القرآن والسنة والأدلة عليه
المطلب الخامس: المظاهر العامة للانفصال بين المنهجية الغربية والمنهجية الإسلامية
المبحث الخامس: عوامل افتقار عقل المسلم للتفكير النقدي ومعاييره
المطلب الأول: العامل اللغوي
المطلب الثاني: العامل المنهجي
المطلب الثالث: العامل المعرفي
المطلب الرابع: العامل الاجتماعي النفسي
المطلب الخامس: معايير التفكير النقدي وخصائص المفكر الناقد
(التجريد، التعميم، السببية، الحتمية، المعقولية والمنطقية، العمق، الاتساق، قابلية الاختبار، الدقة، الوضوح، التحرر من التبعية، النقد الذاتي)
الفصل الأول: الاستدلال الاستقرائي
المبحث الأول: التعريف بالاستدلال الاستقرائي
المطلب الأول: لغة واصطلاحاً
المطلب الثاني: أنواع الاستقراء
المبحث الثاني: مراحل الاستقراء وشروط كل مرحلة
المطلب الأول: ملاحظة المشكلة وتحديدها
المطلب الثاني: البحث عن الأدلة وجمعها
المطلب الثالث: فرض الفروض والتحقق منها
المبحث الثالث: دلالة المجانسة بالأنموذج
المطلب الأول: المفهوم والأمثلة
المطلب الثاني: شروطها ودرجة يقينيتها
المبحث الرابع: استدلال الاقتران والعادة
المطلب الأول: المفهوم والأمثلة
المطلب الثاني: قوته في كثرة النظائر
المطلب الثالث: العادة تُحدث ترجيحاً
المبحث الخامس: استخراج أحكام عامة من قانوني السببية والاطراد
المطلب الأول: المفهوم والأمثلة
المطلب الثاني: قانوني السببية والاطراد في القرآن الكريم
المطلب الثالث: الاطراد الاتفاقي
-تطبيقات
الفصل الثاني: القياس (الاستدلال غير المباشر)
المبحث الأول: التعريف بالقياس
المطلب الأول: لغة واصطلاحاً والأمثلة
المطلب الثاني: القياس في القرآن
المبحث الثاني: قياس العلة ومسالكها
المطلب الأول: السبر والتقسيم أو إدراك الافتراضات
المطلب الثاني: الدوران أو الثبوت بالثبوت والعدم بالعدم
المطلب الثالث: تنقيح المناط أو الفرز والتمييز
المبحث الرابع: التمثيل
المطلب الأول: المفهوم والأمثلة
المطلب الثاني ضوابطه وشروطه
المبحث الخامس: قياس الأَوْلى البرهاني
المطلب الأول: المفهوم والأمثلة
المطلب الثاني: الاستدلال بالملزوم على اللازم
-تطبيقات
الفصل الثالث: الاستنباط
المبحث الأول: المفهوم والدلالة الاصطلاحية والأمثلة
المبحث الثاني: التحليل والتقسيم
المطلب الأول: العقلي
المطلب الثاني: المادي
المبحث الثالث: التركيب والجمع
المطلب الأول: العقلي
المطلب الثاني: المادي
المبحث الرابع: التقدير والاستنتاج
المبحث الخامس: الدقة الاستنباطية وصحتها
-تطبيقات
الفصل الرابع: الحجج والحجج المغلوطة
المبحث الأول: المفهوم والدلالة الاصطلاحية
المبحث الثاني: أنواع الحجج
المطلب الأول: برهانية
المطلب الثاني: جدلية
المطلب الثالث: خطابية
المطلب الرابع: شعرية
المطلب الخامس: الحجة الباطلة
المبحث الثالث: ملامح النص الحجاجي
المطلب الأول: المكونات
المطلب الثاني: العلاقة المنطقية
المطلب الثالث: القيمة الحجاجية
المطلب الرابع: قوانين الخطاب
المبحث الرابع: الحجج المغلوطة وأصلها
المبحث الخامس: صور المغالطات
المطلب الأول: صورية وجوهرية
المطلب الثاني: الغمرض والالتباس
المطلب الثالث: التعمية
المطلب الرابع: التعميم الفاسد
المطلب الخامس: المصادرة على المطلوب
-تطبيقات
الفصل الخامس: المعرفة والكتابة والصدق
المبحث الأول: القيم والأخلاق والمعرفة
المبحث الثاني: منهجية الكتابة
المطلب الأول: معرفة بعلوم العصر
المطلب الثاني: الشك المنهجي
المطلب الثالث: منهج الحديث النقدي والمناهج النقدية التاريخية
المبحث الثالث: النقد الخارجي للنصوص
المطلب الأول: التثبت من النصوص والأصول
المطلب الثاني: نقد المصدر
المطلب الثالث: نقد المؤلف
المبحث الرابع: النقد الداخلي للنصوص
المطلب الأول: التفسير ونقده
المطلب الثاني: العدالة والضبط
المطلب الثالث: التثبت من الوقائع المفردة (روايات مباشرة وغير مباشرة)
المبحث الخامس: التركيب والعَرْض
المطلب الأول: الجمع والتنظيم
المطلب الثاني: البرهان السلبي والإيجابي
المطلب الثالث: التعليل وشروطه
المطلب الرابع: العَرْض ونوعاه
-تطبيقات
الفصل السادس: المناظرات والتصديقات
المبحث الأول: المفهوم والدلالة الاصطلاحية
المبحث الثاني: أنواع المناظرات
المطلب الأول: في العبارة
المطلب الثاني: في الاقتباس
المطلب الثالث: في التعريف
المبحث الثالث: طرق السائل والمـُعلِّل
المطلب الأول: المناقضة
المطلب الثاني: النقض
المطلب الثالث: المعارضة
المبحث الرابع: المناظرة والتصديق
المطلب الأول: المناظرة في التصديق النظري أو تقديم الدليل
المطلب الثاني: المناظرة في التصديق البدهي أو تنبيه الغافل
المبحث الخامس: آداب المناظرة: ما لا يجوز للمناظر
المطلب الأول: الإطناب
المطلب الثاني: الغصب
المطلب الثالث: الإبهام واللبس
المطلب الرابع: المعاندة والمكابرة
-تطبيقات
أهم المصادر والمراجع
-القرآن الكريم.
-مصادر السنة الشريفة.
-الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي (ت: 631ه)، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، بيروت: المكتب الإسلامي، 2010.
-إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، اعتنى به: أحمد عبد السلام الزعبي، المجلد الأول، بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط 1، 1418/ 1997.
-البرهان، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، تحقيق: عبد العظيم الديب، قطر، 1399.
-تاريخ دمشق، ابن عساكر، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دون طبعة، 1415/ 1995.
-التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، أبو الوليد الباجي (ت:474ه)، تحقيق: أبو لبابة حسين، ج 1، الرياض: دار اللواء للنشر والتوزيع، ط 1، 1406/ 1986.
-التفكير الناقد من منظور التربية الإسلامية مع حقيبة تدريبية لتنمية مهاراته لدى معلمي المرحلة الثانوية، عمر الراشدي، بحث لنيل درجة الدكتوراه، جامعة أم القرى، 1427/ 2006.
-التفكير الناقد، ألك فشر، تعريب: ياسر العيتي، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، الرياض: السيد للنشر، ط 1، 2009.
-التفكير النقدي، دليل مختصر، تريسي بويل، جاري كمب، ترجمة: عصام زكريا جميل، القاهرة: المركز القومي للترجمة، عدد 2556، ط 1، 2015.
-الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، تحقيق: محمود الطحان، مكتبة المعارف، 1403/ 1989.
-الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، عدد المجلدات 9، دائرة المعارف العثمانية، دون طبعة، دون تاريخ.
-درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط 2، 1411/ 1991.
-الرحلة في طلب الحديث للبغدادي، تحقيق: نور الدين عتر، دار الكتب العلمية، ط 1، 1395/ 1975.
-الرد على المنطقيين، ابن تيمية، باكستان: دار ترجمان السنة، 1976.
-الرسالة، الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1358/ 1940.
-رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة، عصام الدين أبي الخير طاش كبرى زاده (ت: 968ه)، تحقيق: حايف النبهان، الكويت: دار الظاهرية، ط 1، 2012.
-شرح الفصول في علم الجدل، محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي برهان الدين (ت: 687ه)، تحقيق: شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني، جامعة الملك سعود، 1433/ 2012.
-ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن حسن حبنكه، دمشق: دار القلم، ط4، 1993.
-العقل العربي ومجتمع المعرفة، نبيل علي، جزءان، عالم المعرفة، عدد 370، ديسمبر 2009.
-علم الجرح والتعديل، عبد المنعم سيد نجم، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السنة 12، العدد الأول، 1400ه.
-علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق وشرح نور الدين عتر، بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر، دون طبعة، دون تاريخ.
-الكفاية في علم الرواية، البغدادي، باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال، دائرة المعارف العثمانية، 1357.
-المجروحين، ابن حبان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، بيروت: دار المعرفة، ج 1، 1412/ 1992.
-مجموع الفتاوى، ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، الجزء 32، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عدد المجلدات 37، 1425/2004.
-المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق: محمد عجاج الخطيب، بيروت: دار الفكر، ط 3، 1404/ 1984.
-المدخل إلى فن المناظرة، عبد اللطيف سلامي، قطر: دار بلومزبري، ط 1، 2014.
-المستصفى، أبو حامد الغزالي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1413/ 1993.
-مصطلح التاريخ، أسد رستم، مركز تراث للبحوث والدراسات، ط 1، 1436/ 2015.
-معرفة علوم الحديث، الحاكم النيسابوري، تحقيق: السيد معظم حسين، بيروت: دار الكتب العلمية، ط 2، 1397/ 1977.
-مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، ابن قيم الجوزية، تحقيق: علي حسن عبد الحميد ، القاهرة: دار ابن عفان، 1416ه.
-مفتاح السعادة ومصباح دار السيادة في موضوعات العلوم، طاش كبرى زاده، بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1985.
-مقاصد الفلاسفة، أبو حامد الغزالي، الطبعة المحمودية التجارية بالأزهر، ط 2، 1936.
– المقدمة، ابن خلدون، حققها وقدم لها وعلق عليها: عبد السلام الشدادي، الجزائر: المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، 2006.
– الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، شرحه وخرج أحاديثه: عبد الله دراز، وضع تراجمه: محمد عبد الله دراز، خرج آياته وفهرس موضوعاته: عبد السلام عبد الشافي محمد، بيروت: دار الكتب العلمية، طبعة جديدة في مجلد واحد، الطبعة الأولى، 1425/2004.
-الموقظة في علم مصطلح الحديث، الإمام الحافظ الذهبي، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية، ط 1، 1405.
-الملل والنحل، محمد عبد الكريم الشهرستاني، بيروت: دار الكتب العلمية، 1413/ 1992.
-مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، الكويت: وكالة المطبوعات، ط3، 1977.
-مناهج البحث عند مفكري الإسلام، علي سامي النشار، بيروت: دار النهضة، 1984.
-مناهج البحث في العلوم الإنسانية، مصطفى حلمي، بيروت: دار الكتب العلمية، 1426/ 2005.
-منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب، محمد عبد الكريم الوافي، بنغازي: جامعة قار يونس، ط 3، 2008.
-المنهج الفلسفي عند الغزالي وديكارت للوصول إلى الحقيقة، محمد عقيل بن علي المهدلي، القاهرة: دار الحديث، ط2، د. ت.
-المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية، عبد الرحمن بن نويفع فالح السلمي، بيروت – الرياض مركز نماء للبحوث والدراسات، ط 1، 2014.
-نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول، عيسى منون، عناية: إدارة الطباعة المنيرية، 1345ه.
-نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ابن الجوزي، دراسة وتحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1987.
-نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت: 684هـ) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة: نزار مصطفى الباز، ط 1، 1416/ 1995.
-النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: ربيع بن هادي عمير، النوع الثامن عشر، معرفة العلل، ج 2، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، ط 1، 1404/ 1948.
معاجم:
– الصحاح في اللغة، محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، بيروت: المكتبة العصرية، ط 5، 1420ه/1999م.
– معجم الغني الزاهر، عبد الغني أبو العزم، مؤسسة الغني للنشر،1421ه/2001م.
– معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر وآخرون، 1429ه/2008م.
– المعجم الوسيط، القاهرة: مجمع اللغة العربية، 1379ه/1960م.
– مقاييس اللغة، ابن فارس بن زكريا، راجعه وعلق عليه: أنس محمد الشامي، القاهرة: دار الحديث، 1429ه/2008م.
اسطنبول 1440/ 2019