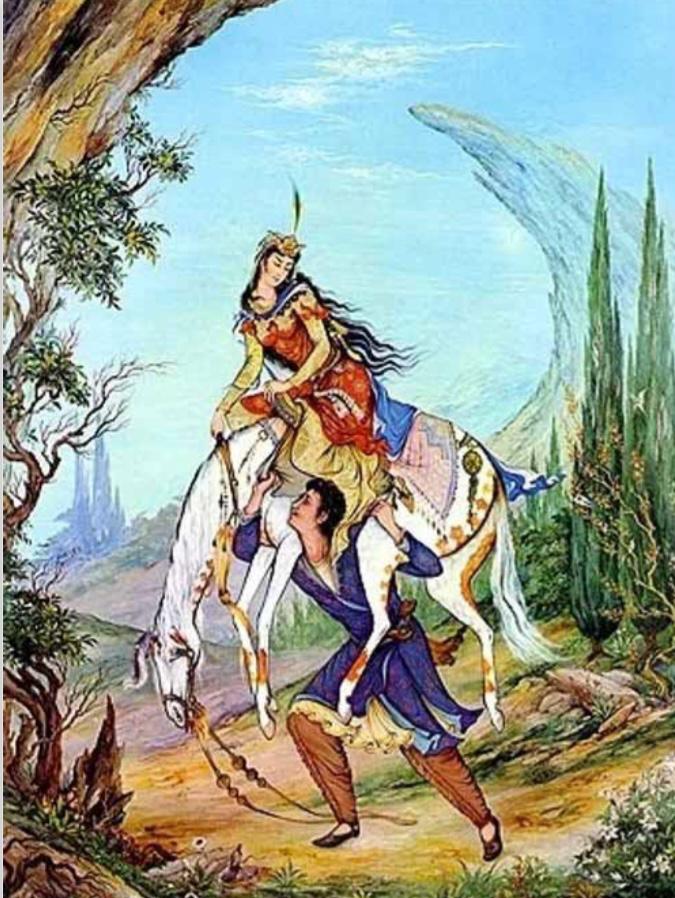إن وضع المرأة المسلمة في المجتمع المعاصر هو محصلة إرث تاريخي مثقل بالنظم الاجتماعية التقليدية، وبقايا مجتمع عبودي قائم على الولاء والخضوع في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يحكمه صراعاً داخلياً بين قطاعاته المختلفة. والمفهوم المحرك لهذا الصراع هو السيطرة أو السيادة المتمثلة بثنائيةٍ طبقيةٍ للعلاقة بين منتصر ومهزوم، محكوم وحاكم، وقد انعكست هذه الثنائية بشكل واضح في علاقة الرجل بالمرأة، فغدت المرأة مُلكاً للرجل، مستثمرة من قبله، ومشيئة لتصوراته.
وواقع حال المرأة المسلمة أنها بين نمطين من الإسلاميين: الأول بعيد عن جوهر الإسلام، انطلق من تقاليد بالية ومن تعصب وغلوّ في الدين، والثاني غريب عنه، تأرجح بين القيم الإسلامية والقيم الغربية، فحاول قراءة القرآن والسنة النبوية بلغة ماركس، فرويد، ديريدا، أو من خلال الفكر الاستشراقي، ولم يراعِ بذلك خصوصية المجتمع العربي الإسلامي، وأنتج امرأةً مغتربة عن ذاتها العربية الإسلامية، حَكَمتْها النسبية والازدواجية في القيم. وتلك النماذج حاضرة في مجتمعنا المعاصر التي زعزعت مفهوم المثال المفترض لتمثيل الوعي الديني، وتتجلى تلك الازدواجية القيمية لدى بعض من يطلقون على أنفسهم بالمستنيرين والذين يطالبون بضرورة قراءة التاريخ الإسلامي والنصوص المقدسة قراءة جديدة عصرية، وبما فيها ضرورة إعادة النظر في مسألة الحجاب على سبيل المثال، وهم أنفسهم يقرون في مناسبة أخرى بأن سفور المرأة معصية للخالق وأن الحجاب فريضة إلهية على كل مسلمة.
لقد سعت الأدبيات الفكرية منذ بداية عصر النهضة إلى الكشف عن مشكلات وأسباب تخلف وضعف المجتمع العربي ومدى مسؤولية الدين عن هذه الأزمة، وغالباً ما تم نقد الإسلام من خلال وضع المرأة المسلمة الحالي، والتبس على المفكرين أن وضعها اليوم، هو نتيجة تراكم أفكار ومفاهيم من إنتاج البشر أنفسهم لمئات من السنين التي عملت على رفع ما هو موضع خلاف واجتهاد إلى درجة القدسية والثبات، فتحولت القيم المتغيرة إلى “تابوات” يُحْرم مناقشتها أو التفكير فيها. ذلك أن “الجبريّة”، غدت هي المقولة الفلسفية الجوهرية التي بنى عليها المجتمع الإسلامي منظومة تفكيره ومنهجية سلوكه، فاستلب من إنسانيته مقولة “الحرية” وضرورة التحكيم العقلي والاجتهاد السيروري الذي يخاطبنا به القرآن الكريم في عدة مواضع.
لقد جاء الدين لينظم حياة البشر وليسمو بالخلق الإنساني مع الأخذ بالسنن والقوانين التي وضعها الله في العالم. فالإسلام خاطب الإنسان بما هو إنسان أولاً وبما هو مسلم ثانياً، في سبيل بناء مجتمع متمدن يرقى إلى المفاهيم الإنسانية آخذاً بعين الاعتبار ما هو ثابت من القيم والمبادئ الإسلامية، وما هو متغير تابع لتغير الزمان والمكان.
ويتمثل دور الوعي الديني في العالم العربي في إعادة صياغة المفاهيم والأفكار التي حكمته قروناً طوالاً وأدت إلى وضعه الراهن من تخلف وتأخر عن ركب الحضارة الإنسانية.
المشكلة المطروحة إذن، هي كيفية فهم التراث الإسلامي ونقل مُثُله وقيمه النظرية إلى مجال التطبيق العملي، لخلق نماذج حيّة وفعّالة تحرر الدين من أسر التقاليد التي اكتسبت صفة القدسية.
ومن هنا، فإن موضوع المرأة ودورها في تأسيس الوعي الديني يشكل واحداً من أهم المشكلات التي تحتاج إلى إعادة توضيح وتقييم.
إن المجتمع السوري قائمٌ على تعدد الأديان، وعلى تعدد المذاهب ضمن الدين الواحد، وعلى فروق طبقية تعكس أنماطاً اجتماعية مختلفة. وسيكون بحثنا هنا منصباً على استقراء دور فئة من النساء المسلمات (الأم، الداعية، المعلمة) من الطبقة الاجتماعية المتوسطة، ومن ثم سنتناول نموذجاً من واقع الوعي الديني في مسألتي الإفضاء الجسدي والحجاب، وما يجب أن يكون عليه هذا الوعي.
لم يمنع الرجل المسلم العصري المرأة المسلمة من حقها في التعليم، كما في غابر الأزمان. وهو على الرغم من اعترافه بكمال عقلها على استحياء، -لضرورة الحالة المعيشية الصعبة التي تستدعي مشاركتها الاقتصادية- إلا أنه يخاف هذا العقل، لذلك نراه مازال يقف ضد مشاركتها على الصعيد التشريعي والقضائي والسياسي.
وبالرغم من ازدياد عدد النساء المتعلمات وحصولهن على مكانة جيدة في الحياة العلمية والعملية ومن تحقيقهن لبعض من الاستقلال المادي، -حسب إحصاءات من يستند إلى هذا الأمر كمعيار عن رفع الظلم عنها- إلا أنهنّ ما زلنّ يخضعنّ لمكانة اجتماعية دونية ضمن الأسرة. ويعود ذلك إلى التفاسير الخاطئة للآيات القرآنية المتعلقة بحقوق المرأة وواجباتها والتي تحول تطبيقها إلى ممارسات اجتماعية تقليدية أنتجت امرأة ارتضت هي ذاتها، كأم، هذه الحالة من الخضوع والاستسلام.
ومن هذه المفاهيم حجب المرأة المسلمة عن المجتمع، وقوامة الرجل على المرأة. فالآية القرآنية (وقرن في بيوتكن) فسرها الرجل بشكل خاطئ واتخذها ذريعة لحجب المرأة في المنزل وحرمانها من ممارسة دورها الفاعل بوصفها القطب الآخر للمجتمع الإنساني، فحكم عليها من ثم بالخضوع، وحَصَر دورها بالعمل المنزلي والإنجاب، فأصبحت حياتها كما يقول ابن رشد الفيلسوف أشبه بحياة النباتات أو أتعس حالاً. والمصطلح عليه في مجتمعنا، أن المرأة بعد الزواج تخمد وتُستهلك داخل المنزل. وهو ما يلخص فكر شريحة واسعة من الجامعيات اللواتي وصلن إلى مرحلة متقدمة من التعليم وما زلنّ يحملنّ أفكاراً متخلفة لا أثر فيها للوعي أو الثقافة حول مسؤولية المرأة ودورها في بناء المجتمع وتطويره عبر تنشئة أولادها أولاً.
لا شك أن دور الأم ومسؤوليتها في تنشئة أطفالها وتوعيتهم من أهم وأعظم الأدوار التي خصّ الله بها المرأة. فما تزرعه الأم في نفوس بناتها وأبنائها يلعب دوراً جوهرياً في صقل شخصياتهم، فهم غالباً ما يتمثلون أنماط تفكير أسرهم ذاتها لتنعكس في سلوكهم عند النضج. ولكن غالباً ما تكون الأم متأثرة في العمق بالعادات البالية لهذا المجتمع، فتمارس على أطفالها دون وعي منها الظلم نفسه الممارس عليها، مما جعل من ذكور المجتمع العربي الإسلامي (رجال المستقبل) يعدون أنفسهم مستقلين عن أي نظام قيمي، ولم يلتفتوا كثيراً للمبادئ الدينية الصحيحة، حيث أنهم رضعوا حصانتهم القدسية منذ نعومة أظفارهم وورثوا العديد من الامتيازات الباطلة كفكرة تمييز الذكر وحصوله على كافة الحقوق بالتفضيل على إناث الأسرة لكونه ذكراً فقط!
بل نجد في كثير من الأحيان إهمالاً حقيقياً للأسر في تعليم البنت وتثقيفها، وتقصيراً متعمداً أو بطريق الجهل في توعيتها الدينية. ويعود ذلك إما لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو عقيدية أو شخصية، حتى أصبح الهمّ الأساس للأسر العربية المسلمة هو تأمين البعل القادر على صون شرفهم وعرضهم.
وقد يختلط على الملاحظ كثيراً أن الفتاة المسلمة متمسكة أكثر من الفتى المسلم بالتعاليم الدينية، إلا أن ذلك صحيح في الظاهر فحسب، فمنذ نشأة الفتاة يمارس عليها التشديد للتقيد بما هو سائد من أفكار تقليدية، بطبيعة كونها أكثر التصاقاً بالمنزل وبأسرتها، ومن ثم تُخلق فتاة حاملة لمنظومة فكرية بعيدة عن جوهر مبادئ الدين الإسلامي، فقد نجد الكثير من الفتيات المسلمات يرتدين الحجاب ويمارسن الشعائر الدينية، إلا أنها مظاهر خالية من الوعي الحقيقي لتلك الفروض، وإن سُئلت إحداهن عن ماهية مسؤوليتها كامرأة تجاه مجتمعها وحقها في ممارسة كافة الأدوار الاجتماعية الممكنة التي أمر الله بها، فإنها لن تجيب إلا عن دورها كأم الذي كُرسّ مع الزمن لتوريث التربية البعيدة عن التربية الإسلامية وتعزيز تفضيل الذكر على الأنثى على غير وجه حق.
القلة القليلة من الفتيات وجدنّ أن هناك خللاً كبيراً بين نشأتهن ونشأة الذكور في تلك الأسر، فاضطربن نتيجة التفاوت العميق في ممارسة الحقوق والواجبات وأخذن يناقشن ويحللن النصوص الدينية واصطدمن مع محيطهن، لاسيما أمهاتهن من صاحبات المنظومة الفكرية القديمة، ذلك أن الكثير من الأحيان تخسر هذه الفتاة أو تلك معركتها لما كانت بين تيارين؛ تيار تقليدي شديد التسلط وتيار مزدوج المعايير، إلى درجة أننا لا نستطيع الجزم بوجود تلك الفئة الكافية من الفتيات اللاتي استطعن الخروج على أحد هذين التيارين بهدف إحداث نقلة نوعية في فهم أهمية دورهن في التغيير والإصلاح.
أما المفهوم الثاني فهو قوامة الرجال على النساء، في قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) فالرجل قوّام على المرأة بتكليفه أمور الرعاية المعنوية والمادية بشكل ودّي، ومن ثم لتعديل التمييز الحاصل في الميراث، وليس إذناً لممارسة التسلط والاستغلال والإذلال.
هذان المفهومان من جملة المفاهيم الخاطئة التي التصقت بالدين الإسلامي وشوّهت آلية تفسير آيات القرآن الكريم.
لقد أقر الإسلام للمرأة بأهلية التصرف في مالها وفي حقها بالملكية الشخصية وحق الولاية على القاصرين وحق مشاركتها الاجتماعية والسياسية والفكرية، وإلا كيف يستوي عدم إقرار مجتمعنا بتلك الحقوق مع تسويتها بالرجل في وقوع الحد عليها عند ارتكاب الجرائم.
أما النموذج الثاني الذي اخترناه في بحثنا هذا فيتمثل في شكل الداعية، حيث يختلف دورها وانعكاسه على المجتمع باختلاف الظروف التربوية والنفسية الخاضعة لها وباختلاف الجماعة الإسلامية المنتسبة إليها.
يتجسد عمل الداعيات في جذب أكبر عدد ممكن من النساء، بطرق مختلفة إلى حلقة الدرس، والتي تعقد في أحد المساجد أو في منزل إحدى النساء، يوماً في الأسبوع.
وتكون تلك الحلقات على نوعين: فإما أن تُخصص لتلاوة القرآن الكريم وتعلم تجويده، أو حفظه، ومن ثم تمنح الإجازات لمن تحفظه كله أو تحفظ أجزاءً منه.
وإما أن تتناول كتباً عن العقيدة الإسلامية وما تشتمل عليه من فقه العبادات والفروض والحدود الشرعية، بالإضافة إلى قراءة السيرة النبوية وسير الصحابة والتابعين. وعند انتهاء المقررات، يتم اختبار النساء والطالبات بطرح الأسئلة حول تلك الكتب وأخذ الاستبيانات عن مدى وكيفية تأثيرهن في محيطهن القريب. مع أهمية هذا الأسلوب وليس تقليلاً من شأنه إلا أنه لابد من القول، أنه نادراً ما نجد الداعية تتحدث عن القضايا الكبرى التي تواجه حضارتنا الإسلامية والتي تحتاج إلى توعية وتثقيف أكثر، مثل حقوق الإنسان في الإسلام، وحرية الرأي واحترام الرأي الآخر، وكيفية مواجهة كافة أشكال الاستعمار، والاهتمامات العلمية والأدبية والفلسفية، والتي هي من أساسيات الوعي الإنساني أولاً ومن ثم الوعي الديني.
لا بل والأسوأ من ذلك أيضاً اعتماد بعض الداعيات أسلوب الترهيب والتخويف، والتعسير لا التيسير، وكثرة اللاءات الناهية في خطابهن الديني، وقد أحطن أنفسهن بهالة من القدسية، وبمرتبة متعالية على بقية النساء، فلا يحق للطالبات مناقشتهن أو معارضتهن في أي مسألة فقهية قد يُختلف فيها من مذهب إلى آخر. وغالباً ما ينتج عن تمثل النساء لأفكار ومفاهيم ذلك النموذج -بل وتكرارها- دون إعمال العقل أو تحكيم المنطق، إلى الإضرار ببنى الأسر المسلمة. والمشكلة أن من تعدّ نفسها موجهة دينية وتأخذ على عاتقها مسؤولية توعية النساء دينياً لا تعنى كثيراً بفهم المبادئ والأصول الجوهرية للشريعة الإسلامية، وغالباً ما تهتم بالقشور وتردد الأفكار التقليدية، مما عزّز تخلف الأفكار السائدة في تلك الفئة. أضف إلى ذلك، أن تعدد الحركات الإسلامية التي تتحرك المرأة الداعية في محيطها أدت إلى تشتيت النساء وخلقت منهن آلات إيديولوجية تحارب كل جماعة نظيرتها، وخلقت الانقسامات في صفوف النساء المسلمات وتعددت الأهداف والاتجاهات والانتماءات العقيدية وعجزت عن إقامة حوار بنّاء بين تلك الجماعات من جهة وبينهن وبين الرجال، أبناء مجتمعهن من جهة ثانية.
أما المدرِسات في المدارس العامة أو الخاصة، فيتمثل دورهن في ترديد وتكرار ما جُمع في المناهج التربوية المقررة من قبل وزارة التربية، التي هي في الأصل مادة ثانوية قائمة على ملكة الاستحفاظ، دون ممارسة أي دور فعّال في تصحيح المفاهيم الخاطئة أو تنمية الحس النقدي للطلاب.
المرأة في كافة صورها، لا تمارس أي دور فعّال في مجال التوعية الدينية في الاتجاه القويم، بل إنها صدى للأفكار والمفاهيم التقليدية المشوهَة لجوهر الدين الإسلامي.
ولنتدرج في عمق تلك المشكلة لنكتشف مدى سيطرة هذه المفاهيم الخاطئة على عقول النساء والرجال معاً.
الوعي الديني في مسألتي الإفضاء والحجاب، الواقع وما يجب أن يكون:
في ضوء ما عرض أعلاه، فلن نستطيع التحدث عن وعي المرأة المسلمة دينياً في ضوء تلك المسألتين دون أن نقف على وعي الرجل ومسؤوليته اتجاههما.
تُعد الحاجة الغريزية للإفضاء قوة من القوى الخفية المحركة للمجتمعات، فإما أن تُفهم على أنها حاجة حيوانية غريزية بحتة كالطعام والشراب منفصل تماماً عن المنظومة الأخلاقية، فيُبَرر لجوءنا إلى إشباعها بأي وسيلة كانت، كما قد يحدث في سرقة طعام الآخرين أو البحث عما يسد الرمق في حاويات القمامة! وإما أن يتم تهذيبها وفق نسق أخلاقي منظم، يرتقي من خلاله الكائن الحي من حيوانيته إلى مرتبة الإنسان العاقل الأخلاقي.
والمرأة هي الكائن المخاطب الأول لعقل الرجل والموجهة السيرورية لأنماط سلوكه، كما أن الرجل هو الرمز الفاعل في نفس المرأة والمؤثر في وجودها، والتفاعل بينهما يتجسد بلغات يتخاطب بها كل منهما، ومن بين تلك اللغات لغة التخاطب الإفضائي الجسدي والمعنوي.
إن الإفضاء مسؤولية أخلاقية كلية ترتبط جذرياً بالمسؤولية الفردية للرجل، وواقع حال الرجل في مجتمعنا متناقض ومزدوج المعايير، حيث لازال في طور “المراهقة الجنسية”، ذلك أنه شخص تعلم منذ زمن التخلف والبعد عن فهم الكينونة الأنثوية وكينونته، أن العين وسيلة التواصل الجسدي الشهواني وبوابة تعويض خسارته وعقده النفسية، ولا يدرك من المرأة إلا جسداً يزيل به توتره الفيزيولوجي، لأنها بنظره “وعاء” خُلقت له، يُشكّلها لمتعته ويُلقي في عقلها ما يتصوره وفي جوفها ما يفيض عنه. فنجد الرجل ذاته مراقباً لحركات النساء ولباسهن، ملاطفاً معجباً بالنساء السافرات حيناً، وتجده حيناً آخر يشعر بخجل شديد إذا ظهرت دلائل الأنوثة على فتاة من أقاربه لأنه ببساطة يُسقط عليها مفهومه عن الأنثى المثيرة للفتن الآخرين، فيأمر بتغييبها وحجبها في المنزل.
ومن هنا اتخذ أغلب الفقهاء حجة تغييب المرأة المسلمة عن مجتمعها وتقييد حركاتها اتقاءً للفتنة، ونسوا خطاب القرآن للرجال من غض البصر وحفظ الفرج والتحلي بالقيم الإسلامية بل والتأسي بخُلُق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وقسّموا الأخلاق إلى أخلاق أنثوية وذكورية، فالتحقت العفة والحياء والمحافظة على الشرف بالخصال الأنثوية وتخلص الرجل من عبء الحفاظ على عفته وحيائه، وارتبط مفهوم شرفه بسلوك أمه أو أخته أو زوجته، دون أدنى إشارة إلى شرف المرأة وكرامتها عند خيانة الرجل لها، أو نقضه لعهد من عهود الله تعالى.
والمشكلة، أن المرأة ذاتها أخذت عن الرجل أفكاره وآمنت بأقواله، وأضحت تعدّ نفسها مسؤولة حتى عن ذنوب الرجل، كيف لا، ومجتمعنا لا يبحث في مصداقية الخرافة اليهودية “إغواء حواء لآدم في معصية الخالق”.
إن الإسلام لم يحبس المرأة في منزلها كونها تشكل فتنة عظيمة للرجل، وإلا لأمر بحجب الرجال عنها، كما لم يحمّلها تبعات شعور الرجل بالضعف تجاه أنوثتها. بل لقد ضيّق المسلمون على أنفسهم في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام واستأذنوا في الاختصاء لما لم يكن بمقدورهم تحصين أنفسهم بالزواج الشرعي[1].
ومن هنا جاء الفرض الإلهي لحجاب المرأة المسلمة. أي بهدف الحماية الروحية والصون الجسدي لها، فآية الحجاب (النور: 59) تخاطب نساء المؤمنين أجمعين، ولا يمكن التسليم بأن نزولها كان مرهوناً بوقت وحالة معينين، أو كما يدعي أحدهم، من أنها اقتصرت على مخاطبة الحرائر من المؤمنات، دون الإماء، حتى لا يُؤذينّ بالقول من فاجر، وحجته أن الحكم في الشريعة ينتفي إذا انعدمت العلة، أي لما انعدم وجود الإماء في عصرنا الحالي انتفى الحكم! إلا أنه أهمل الشق الثاني من وجود العلة في فرض الحجاب وهي وجود الفاجر في كل مكان وزمان، الذي تنوعت طريقة تحرشه وإلحاق الأذى بالمرأة باختلاف وتنوع أصوله التربوية أو انتماءاته الفكرية والعقدية ومؤثرات الانفتاح على العوالم الأخرى والثقافات المتنوعة.
إن لغة تخاطب الجسد هي لغةٌ بين زوجين ارتضى أحدهما الآخر، وليست لغة للمجتمع ككل. والمرأة المسلمة الملتزمة بلباس محتشم تريد أن تقول إنها ليست مشاعاً ومستقراً للأنظار، ولا معبراً للشهوات، وعندما تختار امرأة شريكاً لها كي يتبادلا معاً لغة الحوار بانسجام وتوّدد، فإن خلع حجابها بحضوره يعني أنها أرادته مخاطباً لها جسداً وروحاً.
كانت المرأة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم تَعرض نفسها على الرجل الذي ترضاه زوجاً لمِا تراه من تناسب وتكامل بينهما دون أن يعني ذلك خدشاً لحيائها أو انتقاصاً من عفتها وكرامتها.
وقد ناقش كثير من الفقهاء كابن حزم (384-456هـ)، وابن قيم الجوزية (691-751هـ)، والصوفي ابن العربي (560-638هـ) مسائل الحب والإفضاء الجسدي والمعنوي بين المرأة والرجل دون حرج أو تعصب. بل وقد أفصح بعضهم عن حق المرأة في الاستمتاع واحترام كينونتها الشهوانيّة، وتحميل الرجل مسؤولية تحصينها وإبراز آداب معاشرتها حتى لا يحدث النفور أو الأذى في نفسها. فالفقيه الفيلسوف أبو حامد الغزالي (450-505هـ)، نقض مسلّمة كون الرجل هو الفاعل والطالب نظراً لوضعه الفيزيولوجي، والمرأة هي المنفعلة المطلوبة، فطالب الرجل مجامعة زوجه بحسب حاجتها هي[2].
ومع أن تلك المشاكل من صميم حقوق المرأة إلا أنها في زمن تخلف المجتمع الإسلامي، لم تجرؤ على مناقشتها يوماً. فالإفضاء الجسدي عُدّ من “التابوات” المحرمة عليها واقتصر الخطاب الديني التقليدي على متعة الرجل وحقه على المرأة في هذه المسألة. وعلى المرأة المسلمة أن تدرك أن جملة هذا الخطاب محكومٌ بتجارب وتصورات وتفسيرات خاضعة في عمومها للسياق التاريخي والثقافي.
لقد خاطب الإسلام المرأة/ الإنسان خطاب عقل وأنوثة، وتعامل معها على أنها ندّ وجودي للرجل، مسؤولة أمام الله ومن ثم أمام الإنسانية جمعاء. هي معنية بتفعيل عناصر مختلفة من إنسانيتها، أي أن تشارك في الحياة العامة والاجتماعية، وتدفع بمسيرة الإنتاج والإبداع الفكري، دون أن تنسى عنصرها الأنثوي فتملأ الوجود رقّة وحناناً.
والمسألة المهمة المطروحة هنا، هي أحقية كل امرأة مسلمة أن تقرأ قرآنها الكريم وتتدبر معانيه، مع استصحاب تماهي بعض المعاني مع الواقع ومتطلباته، متمسكة بالأصول دون أدنى تعصب، فهي الأقدر على فهم حقوقها وواجباتها، وأقرب إلى معرفة كينونتها، لتصل بذلك إلى وعي كبير بماهية دورها الوجودي في ضوء عقيدتها الدينية.
وقد مارست المرأة المسلمة في الماضي دورها الفعّال في كافة مجالات الحياة، واشتغلت بقراءة القرآن والحديث والفقه وصولاً إلى التصوف، بل إن أول راوٍ عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان امرأة وهي أم مَعْقِل الأسدية التي روت عنه عشرة أحاديث[3]، ولم يُنقل عن أحد من العلماء بأن ردّ خبر امرأة، أو أنها كَذَبَت في حديثها لكونها امرأة، والتاريخ حافل بفضلهن وعلمهن، نذكر على سبيل المثال من الراويات والفقيهات، ست العرب بنت يحيى بن قايماز بن عبد الله الكندية الدمشقية (599-684هـ) التي تتلمذ على يديها شيخ الإسلام ابن تيمية (542-621هـ)، ومؤرخ بلاد الشام والمحدث الكبير الحافظ الذهبي.
وقد نُقل عن الأشعري أن من النساء من نُبئ وهنّ ست: “حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم”، والضابط عنده أن من جاءه الملك عن الله بحكم من أمر أو نهي أو بإعلام عما سيأتي فهو نبيّ وقد ثبت مجيء الملك لهؤلاء بأمور شتى ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهن في القرآن[4].
إن الطريق شائكٌ وطويلٌ جداً لبلوغ سماء الوعي الديني، ولن يكفِ رفض المرأة المسلمة للأفكار السائدة المبتذلة رفضاً صامتاً، بل يجب أن تحطم ذلك السكون وتعمل على تصفية العقول من الشوائب، وتشارك بصوتها الإنساني الأنثوي بممارسة علنيّة فعّالة في خلق نماذج حيّة قادرة على النهوض بالمجتمع الإسلامي وتمكّن بذلك أخواتها من حقوقهن. فالرجل العصري أثبت فشله بجدارة حين استأثر بإدارته للمجتمع، والدليل ما وصل إليه مجتمعنا من غرق في المادية والنسبيّة القيميّة، وبُعْدٍ عن الروحانية والأخلاق الإنسانية المطلقة، ولن يحقق المجتمع الإسلامي التوازن والتكامل والتمدن إنسانياً أولاً وإسلامياً ثانياً، إلا بتطبيق مقولة نبي الإسلام والعالمين: “النساء شقائق الرجال”.
نُشر في مجلة ILREGNO الإيطالية، يونيو، 2006.
“The role of women in the formation of religious conscience”, 10 pages, published in ILREGNO, June 2006.
[1]– عبد الحليم أبو شقة، تحرير المرأة في عصر الرسالة، الجزء الثالث، الكويت: دار القلم، الطبعة الأولى، 1990، ص 204. ومن الجدير بالذكر أن الرسول الكريم لم يجز لهم الاختصاء بل نصحهم بالصوم.
[2] – المرجع السابق، الجزء السادس، ص233.
[3] -عمر رضا كحالة، أعلام النساء، الجزء الثالث، دمشق: المطبعة الهامشية، 1940، ص 1455.
[4] -عبد الحليم أبو شقة، مرجع ورد ذكره، الجزء الأول ، ص312.