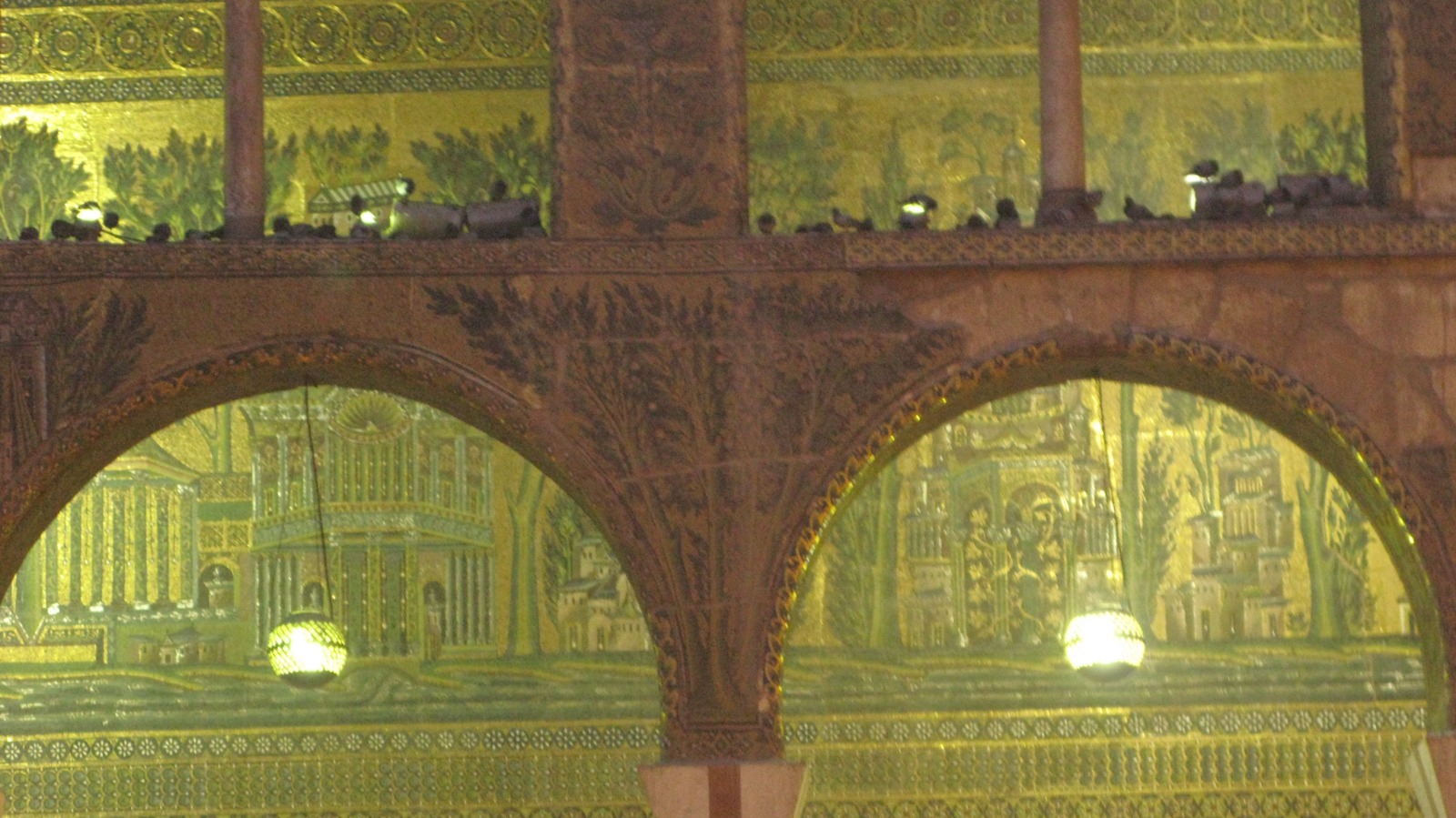بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
نواجه اليوم أعتى حروب الاحتلال الفكري والاستلاب الديني التي خاضها المسلمون في عصورهم، وتمثلت في ضخٍ هائل لعقائد ومذاهب فاسدة ورميها في عقول الناس ولطروحات متعسفة ولأفكار مبتذلة وقيم سطحية من جهة، أو في طرح تفسيرات جاهزة نمطية، وأفكار لا تخلو من أجندات موجهة للأحداث الجارية التي تمر بها أمة الإسلام دون الوقوف عليها أو إعمال العقل فيها، وطغيان التدليس والكذب والتلفيق على أغلب إعلام اليوم بكافة أشكاله والذي أصبحنا معه في ألفة وتآلف عجيبين، من جهة أخرى. بالإضافة إلى التغيير الممنهج المبطن الناعم والمعلن في بنية القيم الاجتماعية والثقافية، دون مساءلة أخلاقية أو وقفة حقيقية مع الذات. ذلك أن العاقل هو الذي يُخضع الخبر أو المعلومة أو الفكرة إلى عملية منهجية دقيقة من تمحيص ونقد وتقييم، وكما قال ابن خلدون في مقدمته: “ولما كان الكذب متطرقاً للخبر بطبعته وله أسباب تقتضيه، فمنها التشيعات للآراء والمذاهب، فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقّه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه، وإذا طاولها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يُوافقها من الأخبار لأول وهلة، وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص فتمتنع في قبول الكذب ونقله. ومن الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار أيضاً الثقة بالناقلين وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح…”[1].
عرف تاريخ العلوم الإسلامية علماً من أجلّ العلوم وأكثرها تدقيقاً وتمحيصاً وتحقيقاً، هو علم الحديث بقسميه: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فأما الأول فهو: “علم يشتمل على أقوال النبي وأفعاله وصفاته، وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، ومعرفة حال كل حديث من حيث القبول والرد، ومعرفة شرحه ومعناه وما يُستنبط منه من فوائد. وأما الثاني فهو: العلم بالقواعد المُعَرِّفة بحال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد”[2]. ويتفرع عن هذا العلم علم أحوال الرجال الذي يعدّ من العلوم الجوهرية لمعرفة مسار الحوادث التاريخية وتطورها، فكان أئمة المسلمين يُخضعون الراوي وحاله للاختبار ويتتبعون سلوكه إن كان عاصياً أم طائعاً، حتى يتبين لهم إن كان مِن مَن يؤخذ عنه أو يُردّ. وقد جاء في القرآن الكريم إشارة لهذا العلم لعظم شأنه، فأثنى على رجال، وذم آخرين من المنافقين، وجرح أفراداً محددين كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6]. وحادثة نزول هذه الآية في الوليد بن عقبة معلومة، حيث بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، ثم رجع من طريقه ظناً منه أنهم سيقتلونه لما كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، ولما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمَّ أن يغزوهم…” الحديث. فبسبب هذا الرجل كادت أن تقع غزوةٌ وقتلٌ وسفكٌ لدماء معصومة. وفي جملة موضوع التثّبت جاء قوله تعالى أيضاً: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} [النّور: 15]. وقوله: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السَّمْع وَالْبَصَر وَالْفُؤَاد كُلّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولًا} [الإسراء: 36]. وعن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: “التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة”([3]). وقال صلى الله عليه وسلم: “كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع”([4])، وقال: “من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين”([5]).
إن هذا العلم علم الحديث؛ رواية ودراية، أو علم الجرح والتعديل لو استقينا منهجه وأدواته وطبقّناه على روايات الأخبار والنقل والحوادث والقصص ورواتها في زمننا هذا وما ينتج عنه من فكر ومذاهب ومناهج شتى، لوقفنا على الكثير من التلبيس والتدليس والتشوه، وربما الكذب والفسوق.
وعليه، يأتي هذا البحث لتبيان أهمية تفعيل مناهج العلوم الإسلامية، والحاجة الماسة للرجوع إلى اجتهادات علماء المسلمين في علوم الحديث وغيره في التأمل والفحص والتحليل والنقد والتثبت والتوثيق والتضعيف.
مشكلة البحث وأسئلته
على الرغم من كثرة الدراسات والمؤلفات التي تناولت موضوع التفكير الناقد وأهميته في عملية تطوير الفكر الإنساني، إلا أننا نكاد لا نعثر على بضع دراسات عن الموضوع من وجهة نظر إسلامية؛ فالغالب الأعم طغيان نظريات الغرب وفلسفاته حول التفكير الناقد وتداولها بين الأوساط الفكرية والعلمية المسلمة تدريساً وترجمة وبحثاً وتقليداً.
ومن الممكن الحديث عن مشكلة البحث عبر الأسئلة الآتية:
- كيف حثّ القرآن الكريم والسنة النبوية على إعمال العقل والنقد؟
- ما أهمية علم التجريح والتعديل في منهجية التفكير الناقد عند المسلمين؟
- كيف وصلت الأمة إلى حالة مستعصية من التبعية المنهجية والتغريب الفكري والاستلاب القيمي؟
- كيف نستفيد من العلوم المنهجية الإسلامية ونعيد تفعيلها في مستويات الحياة كافة؟
محددات البحث
سيتناول البحث مفهوم التفكير الناقد وتأصيله في القرآن والسنة النبوية وسيقتصر البحث على آراء بعض علماء المسلمين التي تجلت فيها عناصر التفكير الناقد، وسيركز على علم الجرح والتعديل كونه واحداً من أهم العلوم المنهجية النقدية عند المسلمين منذ بواكيره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مروراً بابتداء التصنيف في القرن الثالث الهجري وانتهاءً باكتمال هذا العلم مسلكاً وتصنيفاً وتدويناً.
أهمية البحث
تتجلى أهمية البحث في أنه:
- إبراز مسألة من مسائل التأصيل الإسلامي لمناهج التفكير.
- إثراء الأبحاث حول موضوع التفكير الناقد عند العلماء المسلمين.
- المقاربة بين المنهج العلمي الدقيق الذي اتبعه العلماء والمحدّثون في نقل الروايات وتدوينها وبين الكيفية التي يتمّ بها اليوم تداول الإشاعات المضلة والأخبار المفسدة والمذاهب الغريبة بله منهج التفكير بأكمله.
- إعادة الاعتبار للحث على النظر والتأمل واستخدام منهج التحري والتثبت المتبع في علم الجرح والتعديل.
- إظهار تميز المناهج الإسلامية وغناها وقدرتها على بناء منهجية عقلية متوازنة ودقيقة تشكل نموذجاً عالمياً.
- أهمية وضرورة تفعيل التفكير الناقد في حياة المسلم بكافة مجالاته.
سبب اختيار البحث
وصولنا إلى حالة مستساغة من التلاعب على الوعي الجمعي وأخذ العلوم والمعلومات الجاهزة دون إعمال العقل والوقوف عليها، وصل حد التفريط من قِبلنا في النقل والكتابة “عن الفاسق في فعله المذموم في مذهبه، وعن المبتدع في دينه المقطوع على فساد اعتقاده…”[6]، كما قال الخطيب البغدادي.
ومنذ انطلاقة مطالب الشعوب المسلمة في 1432/2011 وأنا شاهدة على مصابنا في تحويل وتشويه حق المطالبة بالحقوق المشروعة للفرد عن جادة طريقها، وفطنت أن وراء هذا المصاب طغيان صفة التحوير الملازمة للسياسي والإعلامي وصاحب السلطة وفقيه السلطان، متراوحاً بين حدّي الانتقاء والإيهام والتدليس والكذب، التي اجتمعت كلها لفرض قواهم علينا والتحكّم بعقولنا ومسار حياتنا حتى جعلوا منا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا تكونوا إمعة”([7])، ما دفعني للنظر والبحث في أصل المشكلة وجذورها وخطرها على الأمة المسلمة ومنهجيتها في التفكير.
منهج البحث
في ضوء المنهج الوصفي الاستنباطي والاستقرائي الذي سأعتمده في هذا البحث سأحاول:
- استقراء آراء علماء المسلمين والمحدثين والنقاد الأوائل وإسهامهم في موضوع التفكير الناقد.
- جمع الشواهد من أقوال ومواقف السلف المتعلقة بعلم الجرح والتعديل واستنباط المنهجية العلمية والتفكير الناقد منها.
منهج الكتابة
- تتبعت النصوص من مصادرها الأصلية.
- صنفت الآراء والاستقراءات حسب الترتيب الموضوعي لتظهر المعاني والدلالات والآفاق لموضوع البحث.
- حافظت غالباً على نقل ألفاظ ومصطلحات العلماء ثم أدرجت فهمي وتحليلي لها.
- لما أنقل فكرة بالمعنى دون اللفظ، أشير بالهامش بقولي: انظر…
المقدمة
الفصل الأول: المنهج النقدي الأول لدى المسلمين: منهج المحدثين النقدي وقواعده
المبحث الأول: تكوين المنهج النقدي الحديثي ونشأته
المبحث الثاني: الأسس الحاكمة لنقد الروايات
المبحث الثالث: قواعد المنهج النقدي للمحدثين
المبحث الرابع: بين منهج المحدثين النقدي ومناهج العلوم الأخرى
الفصل الثاني: علم الجرح والتعديل نموذج للتفكير الناقد
المبحث الأول: تعريف علم الجرح والتعديل
المبحث الثاني: المنهجية النقدية لعلم الجرح والتعديل: أدوات وخطوات ومظاهر
المبحث الثالث: ضوابط الرجال وضوابط المتكلمين في الرجال (النقاد)
المبحث الرابع: مهارات علم الجرح والتعديل وكيفية استعمالها في التفكير الناقد
الخاتمة والتوصيات
المصادر والمراجع
الفصل الأول: المنهج النقدي الأول لدى المسلمين: منهج المحدثين النقدي وقواعده
المبحث الأول: تكوين المنهج النقدي الحديثي ونشأته
المبحث الثاني: الأسس الحاكمة لنقد الروايات
المبحث الثالث: قواعد المنهج النقدي للمحدثين
المبحث الرابع: بين منهج المحدثين النقدي ومناهج العلوم الأخرى
المبحث الأول: تكون المنهج النقدي الحديثي ونشأته
ابتدأت في عصر الصحابة رضي الله عنهم محاولات نقدية من قبل أفراد من المحدثين من صغار الصحابة وكبار التابعين، ثم تطورت حتى نشأ منها منهج المحدثين في النقد وهو منهج خاص بنقد أحاديث وآثار السنة النبوية.
أسس الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته على حفظ الدين بمصدريه القرآن والسنة وأخبرهم أنهم يسمعون منه وسيلقون على غيرهم، وهؤلاء سيلقون هذا العلم على مسامع الذين يليهم… “تسمعون ويُسمع منكم ويُسمع ممن سمع منكم”([8])، فكان الحفظ والنقل أو التبليغ دون تحريف أو كتمان، كمنهج انتهجه الأوائل، وأن يبلغ الشاهد منهم الغائب حيث قال: “ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب”([9]). حتى أن البخاري رحمه الله (ت: 256هـ) بوّب في صحيحه في كتاب العلم باباً حمل عنوان “باب الحرص على الحديث” دوّن فيه امتثال الصحابة والمحدثين لأمر رسولهم فاتخذوه منهجاً لتوثيق تاريخهم وسنتهم. يُضاف إلى ذلك مسألة النشر على مسافات متباعدة وإلى أشخاص مختلفة وضمن هذا المنهج توفير وسائل وأدوات نقدية كافية لصيانة السنة، فكان الدافع القوي لهم في نشر الأخبار أو نقدها هو دينهم الذي دافعوا عنه بكل ما هو نفيس وغال.
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين التبليغ عنه ولو بآية “بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج…”([10])، وقوله “نضّر الله امرؤ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه”[11] روى عنه صحابته الكرام في منهج متكامل يبدأ بأهمية التيقظ عند تحمل الأحاديث والمحافظة عليه بعد سماعها والتعمق في تفقه الأحاديث ومن ثم تبليغها ونقلها بدقة.
وفي مسيرتهم لحفظ السنة من التشويه أو الاختلاط والدسّ أسسوا لعلم تاريخ المحدثين، ثم أسسوا عليه المنهج النقدي الدقيق، والذي اعتمدوه من خطوات كانت بداية بنشر الروايات على شكل واسع وكبير مما شكل لهم معلومات هائلة يستطيعون من خلالها إعمال النقد الدقيق بين المرويات وضرب بعضها ببعض كما قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه (ت: 181هـ): “إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض”([12]).
الحافظ المحدث أبو محمد الحسن الرامهرمزي (ت: 360هـ) كان من أوائل مصنفي علم الحديث حيث قسمه إلى علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية ([13]). وشاع لدى أهل هذا الفن أن علم الرواية هو العمليات الخاصة بنقل السنة وضبطها والتحري والحفظ والتصنيف، أما علم الدراية فهو القواعد التي تضبط سلامة النقل وتعرف بحال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، والعلم بفقه الحديث.
وقد ضمن الرامهرمزي علم الدراية النواحي الآتية ([14]): 1. فقه النص وشرحه واستنباط معانيه واستخراج ما فيه من مسائل العقيدة والأحكام الفقهية. 2. ضبط اختلاف حركة الأسماء والتمييز بين ما اتفقت صورته واختلفت حركته منها. 3. معرفة أنساب الرواة والتمييز بين المنسوبين إلى أجدادهم إلى أمهاتهم والمعروفين بكناهم والمعروفين بألقابهم. 4. التمييز بين الأسامي والكنى المشكلة الصورة التي يجمعها عصر واحد. 5. معرفة رجال الأسانيد وتواريخهم.
ومن خلال تعريف الإمام يحيى بن شرف النووي (ت: 676هـ) في شرحه لمقدمة صحيح الإمام مسلم، الذي يُعد أول تعريفات علم الحديث، يظهر أن المنهج النقدي وعملية التفكير الناقد مندرجة في علم الحديث نفسه، وعليه تكون خطواته: الرصد والكتابة والبحث والتحري والتحقق والتثبت، يقول: “المراد من علم الحديث تحقيق معاني المتون، وتحقيق علم الإسناد والمعلل… وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة، بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفي معاني المتون والأسانيد، والفكر في ذلك، ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة به، ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه، وتقييد ما حصل من نفائسه وغيرها، فيحفظها الطالب بقلبه، ويقيدها بالكتابة، ثم يديم مطالعة ما كتبه، ويتحرى التحقيق فيما يكتبه، ويتثبت فيه، فإنه فيما بعد ذلك يصير معتمداً عليه، ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن، سواء كان مثله في المرتبة أو فوقه أو تحته”([15]).
وقد عدّ بعض المشتغلين من المتأخرين في علوم الحديث أن المنهج النقدي للمحدثين هو نفسه علوم الحديث واصطلاحاتها، والبعض الآخر ذهب إلى أنه الوسائل والأدوات التي اشتهرت في الكثير من المناهج العلمية النقدية كالاستقراء والتحليل والاستنباط والربط والموازنة والمقارنة… التي كانت منهج المتقدمين من النقاد.
وما يميز المحدثون في منهجهم النقدي عن غيرهم أنهم أنشؤوه وأصلوا له وفرعوا عليه ووضعوا أدواته وخطواته وهو محض إنتاجهم من خلال خبرتهم الطويلة في النقد وفطنتهم، وإعمال عقولهم في دقائق المسائل ونقدها، ما أعطاهم حق المرجعية الوحيدة لنقد الروايات وتصحيحها أو تضعيفها.
المنهج إذن نشأ على يد أفراد حاولوا نقد ما ينقله الرواة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تطور الأمر إلى أن برز جماعة عُرفوا بنقاد الحديث، وقد جعلوا آياتٍ من القرآن الكريم تحث على التريث والتحقق والتثبت في نقل الأخبار نصب أعينهم، مثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]. والحديث الصريح “من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار”([16]).
ثم تأسس بعد ذلك علم الرواة وأحوالهم، وقد خصوا العناية الشديدة بالروايات وطبيعتها والرواة وأحوالهم حيث تُبنى عليه أحكامٌ شرعية، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: “إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد”([17]). فالروايات المهمة استخدموا لها مناهج الاستقراء والمقارنة والموازنة الدقيقة، وذلك لأنهم امتلكوا مادة غنية من طرق الحديث ومن رصد كاف لأحوال الرواة، كما اتبعوا الاستقراء في تحرير ألفاظ الحديث ومعانيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: “الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يُفسر بعضه بعضاً”([18]).
ولكثرة المبلغين واحتمال وجود الخطأ أو الكذب استلزم ضبط الرواية وتخريجها وتحديد ثقات المحدثين من ضعفائهم وتمييز الكذاب. وطبقوا منهجية التدقيق والاحتياط باتصال السند والتي جاءت من أهمية حفظ الدين، فنشأ علم الإسناد في أول زمن التابعين؛ فالتابعي قد يروي عن صحابي وعن غير صحابي وعن من ليس بثقة.
هذا التراث النقدي الغني للمحدثين جعل ابن حبان (ت: 354هـ)، أحد النقاد الكبار، يصرح بأن السنة حُفظت على يد هؤلاء المحدثين حفظاً يكاد يماثل حفظ القرآن الكريم، “وذاك أنه لم يكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة، حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف ولا واو، كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآن؛ فحفظت هذه الطائفة السنن على المسلمين…”([19]).
المبحث الثاني: الأسس الحاكمة لنقد الروايات
يمكن تعداد الأسس الحاكمة لنقد الروايات التي اعتمدها المحدثون والنقاد بالآتي:
1- القرآن الكريم هو المرجعية الحاكمة، والسنة أتت إما لتفسيره أو تأكيده أو تفصيل ما هو كلي عام.
2- الدين محفوظ، فلن يضيع منه شيئاً قال الإمام الذهبي: “هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة، لا عمداً ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف ثقة”([20]).
3- السنة لا تختلف اختلافاً متضاداً فيما بينها، ولا سبيل لوجود التناقض والاضطراب في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله كما هو حال البشر غير المعصومين.
4- السنة لا تخالف العقل الصريح، ولا الواقع المشاهد، ولا الحقائق الثابتة فإخبار النبي عن الغيب أو عن خفايا الأمور وحي عن علم الله.
5-أخبار السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر الدين وهي مرتبطة بواقع الناس وسلوكهم، وقد اهتم المحدثون بالحكم على الرواية التي عليها العمل.
6-كما اهتموا بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من الآثار من أقوالهم وأفعالهم واعتبروها رافداً مهماً في فهم السنة ومرجحاً في نقد الروايات.
قلنا إن المنهج النقدي عند المحدثين هو الطريق الذي سار عليه نقاد الحديث في الحكم على الروايات من قبول ورد، ثم لما جاء المتأخرون من النقاد ابتكروا منهجاً نقدياً مكملاً خاصاً بالكتب الحديثية ونسخها من عمليات التتبع والمقارنة وإصدار الأحكام، يعملون بمقتضاه على قبول النسخ وضبطه وتوثيق ما يستحق التوثيق ورد من استحق الرد.
ترك المتقدمون من النقاد إرثاً كبيراً من الأحكام النقدية على المتون والأسانيد والرجال كان كافياً للمتأخرين من النقاد. فكان عملهم جميعاً يتسم بالتكاملية والدرجة العالية من الاحتياط والتدقيق. عصر ما بعد الرواية اتبع فيه النقاد منهجاً دقيقاً مكملا لمنهج النقاد الأوائل حيث عملت بمجموعها على جمع ملخص كاف واف عن روايات عصر الرواية، وحوت ملخصاً كاملاً من الطرق الكافية للموازنة والترجيح للاستفادة منه في منهج النقد، وذلك عبر المراحل الآتية:
-الإكثار من تأليف المسانيد والتكرير في الروايات. وهذا ما نلحظه في كتابة أئمة الأحاديث، لكل منهم مسند من رواياته إلا فيما ندر.
-ثم بعد مرحلة التأليف في المسانيد، تأتي مرحلة تدوين الأحاديث الصحيحة، كصحيح البخاري ومسلم، وأتى بعدها إكمال ما لم يخرجه الشيخان كالحاكم النيسابوري.
-ثم تخصص المؤلفات في أحاديث الأحكام، كسنن الترمذي وابن ماجه والنسائي والبيهقي…
-ومن ثم إكمال التراث النقدي للحديث بعضه بعضاً.
المبحث الثالث: قواعد المنهج النقدي للمحدثين
يمكن تلخيص القواعد عبر النقاط الآتية:
1. يجب تصديق الرواية دون إعمال البحث أو الاستدلال إن جاءت من طرق متعددة متباعدة يؤمن تواطؤها على الكذب، ولا وجود لمخالف لها. وهذا هو ما عُرف بالسنة المتواترة. مثال: عدد الصلوات الخمس المفروضة في الإسلام.
2. أما الرواية التي لم تصل حد التواتر فإنه يجب إعمال البحث والاستدلال لقبولها أو ردها، وذلك من خلال النظر في القرائن المتعلقة بها، وبالراوي، وجمعها بالاستقراء ومن ثم الموازنة والترجيح فيما بينها. ويصل الناقد إلى أربع نتائج محتملة إما أن تكون الرواية: يقينية الثبوت. أو راجحة الظن مع وجود احتمال عدم الثبوت. أو عدم الثبوت يقيناً. أو راجحة الظن مع وجود احتمال الثبوت.
3. الرواي وأحواله: تفاوت وثاقة الرواة عائد إلى درجة كذبهم وخطئهم. لكن الأصل هو قبول رواية الثقة إلى أن تدل القرائن على خطئه، كما أن الأصل عدم قبول رواية غير الثقة إلى أن تدل القرائن على صدقه([21]).
4. المصدر وتوخي اتصال السند من رواة عدول ثقات ضابطين.
5. إذا تعددت طرق الرواية كانت إلى القبول أقرب من الرواية المنفردة.
6. اختلاف الرواة في الرواية يُحسم بترجيح إحدى القرائن كالكثرة والوثاقة. ومن هنا نشأ علم العلل، وبناءً على هذه القاعدة تشدد المحدثون في قبول أحاديث الأحكام وتساهلوا في أحاديث الفضائل والمغازي والسير…([22]).
7. يتقوى الحديث الذي جاء من طريق ضعيف إن جاء بطريق آخر دلت القرائن على تقويته.
8. التوقف في قبول رواية المجاهيل.
المبحث الرابع: بين منهج المحدثين النقدي ومناهج العلوم الأخرى
يُعد منهج المحدثين النقدي ضمن مناهج النقد التاريخي؛ لكنه يمتاز عنه بأنه أدق ويُعنى بالتفاصيل الدقيقة بمنهجية عالية. وفي الواقع لم يعرف التاريخ منهجاً دقيقاً في نقل الرواية وتمحيصها ونقدها مثل ما عرفه المسلمون.
تركزت جهود المحدثين ونقاد الحديث على التوثيق والعناية بالمهم من التاريخ، ولولا هذه المنهجية لضاع التاريخ كله، وهو ما نحتاج لاتباعه في عصرنا هذا في تدوين الأحداث والوقائع المهمة التي تصيب أمتنا حتى لا يضيع تاريخنا، أو يُصاب بالتشويه والكذب والتحريف وقلب الحقائق. وهذا بالضبط ما دفع أسد رستم للاعتراف بأن للمسلمين السبق بوضع مناهج نقدية على الغرب، بينما يذهب المسلمون اليوم للبحث عن مناهج الغرب النقدية!
يقول: “ولو أن مؤرخي أوربا في العصور الحديثة اطلعوا على مصنفات الأئمة المحدثين، لما تأخروا في تأسيس علم المثودولوجيا حتى أواخر القرن الماضي”([23]).
ويعود السبب الجوهري في التفريق بين المنهج التاريخي ونقد الوقائع التاريخية وبين المنهج النقدي الحديثي ودقة هذا الأخير كما يشرح السلمي إلى “ثراء تاريخ السنة بالنسبة للوقائع التاريخية، فتاريخ السنة توفر له من الرواة والروايات والمؤرخين الذين يرصدونه ويوثقونه ما يفي بالمحاققات التفصيلية الدقيقة في رواياته المهمة، أما الوقائع التاريخية فقلت وثائقها؛ إذ لم تلق كثير من الوقائع التاريخية من يرويها أصلاً، ولم يتوفر لوقائع أخرى إلا رواة لم تشتهر عدالتهم، على عكس روايات السنة النبوية المهمة التي كثر رواتها حتى أصبح عدم وجود الرواة الثقات في أسانيدها دليلاً على ثبوتها”([24]).
كما أن الملاحظة المباشرة للرواة الثقات عبر الأسانيد التي انتهجها نقاد الحديث تتطابق مع المنهج التجريبي المطبق في المجالات العلمية بشكل كبير، “الكيميائي إذا أجرى تجربة مخبرية، ثم نقلها لغيره، فإن الآخر ليس له ملاحظة مباشرة، وهو يعتمد على ثقته بصاحب الملاحظة المباشرة، والواقع يشهد أن المعارف التجريبية لا يجري التحقق منها مخبرياً عند كل من بلغته، لكنهم يكتفون في عامتها بالثقة بصاحب الملاحظة المباشرة والناقلين عنه، فإذا كان مبنى كل العلوم على ذلك، فلا غضاضة ولا ضعف في معارف المحدثين؛ خاصة وأنهم يجبرون ذلك أيضاً بمنهج نقدي يراعي (الروايات في الباب) أي الملاحظات المباشرة التي لاحظها الآخرون من أقران (الراوي الأول) في نفس المعنى، والتي تحكم بمجموعها على روايته، فما روى عن أبي هريرة عندهم محكوم بما رُوي عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم”([25]).
تميز منهج المحدثين النقدي عن غيرهم من المناهج النقدية التاريخية أو الإنسانية في أن المحدثين في استعمالهم لأدوات نقدية أنتجوا قانوناً كاملاً مكتملاً يُطبق على أية رواية من روايات السنة النبوية ليثبت صحتها أو ضعفها. وهذا القانون النقدي أنتج علوماً نقدية والتي بدورها كوّنت لغة ومصطلحات خاصة ما أوصل إلى ما يُعرف بمصطلح الحديث الذي نشأ عن تشكل أنواع مختلفة من الروايات فيميز الناقد كل نوع عن غيره. فعلوم الحديث المعروفة بـ: الإسناد المنقطع والمتصل، والمرسل والمعضل والمعلق والمدلس وتفرع مستوى معين من القوة والضعف لكل منها… هي نتاج عملية منهجية نقدية دقيقة.
بقي أن ننوه إلى أن إدراك المحدثين والنقاد بشكل دقيق الجزئيات والتفصيلات والفروق فيما بين هذه العلوم جعلهم يقبلون بالروايات ذات الطابع الوعظي والآداب والفضائل بمنهجية متساهلة أكثر وتشدد أقل من حيث إخضاعها للنقد الدقيق.
الفصل الثاني: علم الجرح والتعديل نموذج للتفكير الناقد
المبحث الأول: تعريف علم الجرح والتعديل
المبحث الثاني: المنهجية النقدية لعلم الجرح والتعديل: أدوات وخطوات
المبحث الثالث: ضوابط الرجال وضوابط المتكلمين في الرجال (النقاد)
المبحث الرابع: مهارات علم الجرح والتعديل وكيفية استعمالها في التفكير الناقد
المبحث الأول: تعريف علم الجرح والتعديل
تعريف الجرح لغة: هو التأثير في البدن بشق أو قطع، واُستعير في المعنويات بمعنى التأثير في الخُلُق والدين بوصف يناقضهما. اصطلاحاً: رد الحافظ المتقن رواية الراوِي لعلة قادحة فيه أو في روايته من فسق أو تدليس أو كذب أو شذوذ أو نحوها.
التعديل لغة: هو التقويم والتسوية، واُستعير في المعنويات بمعنى الثناء على الشخص بما يدل على دينه القويم وخُلُقه السوي. اصطلاحاً: وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته([26]).
فعلم الجرح والتعديل هو: القواعد التي تتبع لمعرفة الرواة التي تُقبل رواياتهم أو تُرد ومراتبهم في ذلك.
ومع تعريف ابن الصلاح (ت: 643هـ) للحديث الصحيح من أنه “الحديث المسند، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً، ولا معللاً… “([27])، نجد أنه تعريف المنهج النقدي للمحدثين نفسه، لكن مع استقراء مناهج المحدثين والنقاد في الجرح والتعديل يظهر لنا أنهم طبقوا عملياً هذا التعريف حيث كان منهجهم دقيقاً ثابتاً متبعاً لتلك الخطوات، وأن ابن الصلاح أخذ عنهم ألفاظهم وقواعدهم وأخرجها لنا بهذه العبارة، كما سنشرح في الفقرة الآتية.
المبحث الثاني: المنهجية النقدية لعلم الجرح والتعديل: أدوات وخطوات
أدوات المنهجية النقدية
عُرف الجرح والتعديل وعُرف تاريخ الرواة عبر السماع والمشافهة بين النقاد وبين النقاد وتلاميذهم. ثم أتت مرحلة تأليف كتب غير مرتبة ولا مصنفة عن الرجال والروايات وعللها؛ مما كونت قاعدة من المعلومات كبيرة جداً، هيأت لتأليف كتب طبقات الرجال وتراجمهم وتواريخهم، مثل الطبقات الكبرى لابن سعد؛ وتاريخ البخاري الكبير؛ وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم… ثم أتت مرحلة أكثر تخصصاً والتي تعد من المصادر الأساسية في الرجال ونقدهم ونقد رواياتهم فألف العلماء كتباً خاصة بالرجال الثقات ككتاب الثقات لابن حبان، وكتباً أخرى عن الضعفاء من الرجال مثل الكامل في الضعفاء لابن عدي؛ والمجروحين لابن حبان، وكتباً معنية برواة البلدان كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتاريخ نيسابور للحاكم النيسابوري وتاريخ دمشق لابن عساكر… وأخرى برواة كتب معينة مثل كتب الأصول الستة كتهذيب الكمال للمزي.
أما الخطوات المنهجية التي يتبعها الناقد عند تعارض الجرح والتعديل، فهي: التثبت من أن التعارض حقيقي؛ ثم يقوم بالترجيح؛ ثم التوقف عند عدم وجود مرجح وعند تساوي الأقوال.
وفي عملية نقده تلك يتبع منهجاً دقيقاً عبر الخطوات الآتية[28]: 1. جمع الوثائق بمنهجية نقدية استردادية. وهي عملية إثبات القول أو الفعل المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التحقق من تحديث الراوي الأخير بالرواية، ثم بالطريقة نفسها يثبتون تحققها عن شيخه وعن الراوي الأول (الصحابي) الذي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم.
2. الملاحظة المباشرة المنقولة عن ثقات عبر الأسانيد.
3. ثم تأتي عملية النقد الخارجي التي تطبق على تصحيح الإسناد عبر جمع معلومات وتواريخ للتأكد من وثاقة الرواة وأحوالهم، مع عقد المقارنات، ومن اتصال السند بينهم من أول السند إلى منتهاه.
4. بعدها عملية النقد الداخلي؛ أي تصحيح الحديث عبر مقارنة المرويات، وجمع أحاديث الباب، والنظر في الانفرادات، والنظر في المعضدات، وعمل موازنات وترجيحات للتحقق من ضبط ألفاظ الرواية ومعانيها.
المبحث الثالث: ضوابط الرجال وضوابط المتكلمين في الرجال (النقاد)
ضوابط الرجال (الرواة)
يُشترط أولاً العدالة لضمان أن الراوي بعيدٌ عن تعمد الكذب لتوخيه الدائم للتقوى والورع، فوحده من يخشى الله في حركاته وسكناته يمتنع عن الكذب. قال ابن سيرين (ت: 110ه): “إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم”([29]).
والعدل اصطلاحاً: من كان له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة وهو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. من كان خيره يغلب شره.
وقد أخبرنا ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم “لم يرد خبر العدل قط، لا في رواية ولا في شهادة، بل قَبِلَ خبر العدل الواحد في كل موضع أخبر به… وقبل خبر تميم وحده وهو خبر عن أمر حسي شاهده ورآه فقبله ورواه عنه…”([30]). ويكمل بأن “الخبر الصادق لا تأتي الشريعة برده أبداً، وقد ذم الله في كتابه من كذّب بالحق، ورد الخبر الصادق تكذيب بالحق وكذلك الدلالة الظاهرة لا ترد إلا بما هو مثلها أو أقوى منها، والله سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق، بل بالتثبيت والتبيين، فإن ظهرت الأدلة على صدقه قبل خبره، وإن ظهرت الأدلة على كذبه رد خبره، وإن لم يتبين واحد من الأمرين وقف خبره”([31]). “وأقوى الأسباب في رد الشهادة والفتيا والرواية الكذب، لأنه فساد في نفس آلة الشهادة والفتيا والرواية، فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال، [….] فإن اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذي تعطل نفعه، بل هو شر منه، فشر ما في المرء لسان كذوب…”([32]).
ثانياً المروءة ومعناها أعم من التقوى وخوارمها أعم من أسباب الفسق، فكل مفسِّق خارم للمروءة وليس كل خارم للمروءة مفسقاً. ويؤخذ في عين الاعتبار خوارم المروءة بحسب الأعراف في كل بلد وزمان. وكان اشتراطها للتثبت من سلامة الدين والعقل.
والمنهجية المتبعة في هذا المقام أن من تبين أنه فعل قادحاً ظنياً، كفعل مباح لكنه من سمات أهل الفسق أو السفه، لكن عُرف عنه سلامة الدين والعقل، فيُقدم وقتئذٍ اليقين على الظن، ولا يُخرج من أهل العدالة.
إلا أن هناك فُساق التأويل كالمبتدع المتأول غير المعاند، وله شروط: فمنهم “من رد روايته مطلقاً، لأنه فاسق ببدعته […] ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن […]. وقال قوم: تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء…”([33]).
فالثقة الصدوق الضابط قد يُخطئ أيضاً بلا قصد في حديثه، وهذا ما لم يفت على النقاد، بل رصدوا هذه الروايات وعلموا خطأه من خلال أمرين: إما أن يخالفه أحد أقرانه في الرواية نفسها، أو عدم وجود من يتابعه على الرواية نفسها.
“ولما كان التبليغ عن الله ‑سبحانه‑ يعتمد العلم بما يبلغ، والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفُتيا؛ إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون عالمًا بما يبلغ، صادقاً فيه، ويكون مع ذلك حَسن الطريقة، مرضي السيرة، عدلاً في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله؛ وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السّنيات، فكيف [بمنصب التوقيع] عن رب الأرض والسماوات؟”[34].
ثالثاً- اشتراط السلامة من العلل والشذوذ ([35])، وشرط انتفاء العلة يكون بعد استقراء اختلاف الرواة وتبيين القرائن المرجحة بين الروايات المختلفة، فإن اختلفوا فإما أن تقبل كلها إذا كانت أوجه الاختلاف غير متضادة أو ترد كلها إذا لم تُضبط الرواية كما يجب لها، أو أن يُحكم لبعضها بالرجحان وتضعف الأخرى إذا دلت قرائن الترجيح على ضبط بعضهم وضعف ضبط الآخرين.
رابعاً- الضبط هو الخطوة الثانية من القانون النقدي من جهة ضمان عدم خطأ الراوي يقول ابن الصلاح([36]): “يعرف كون الراوي ضابطًا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقاة المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ‑ولو من حيث المعنى‑ لرواياتهم، أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطاً ثبتاً، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم، عرفنا اختلال ضبطه، ولم نحتج بحديثه”.
فالضبط هو نقل الراوي لما تلقاه كما هو لفظاً أو معنى. والضابط هو من كان نقله للأثر مطابقاً لما تلقاه عن شيخه، لفظاً أو معنى.
وفي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يظهر دقة الفهم والمتمثل في تطبيق منهجٍ استقرائي بالغ الدقة، حيث رأى ابن حنبل يحيى بن معين في زاوية بصنعاء، وهو يكتب صحيفة (معمر عن أبان عن أنس)، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه. فقال أحمد بن حنبل له: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس؛ وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه؟ قال: رحمك الله يا أبا عبد الله! أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبان، عن أنس) وأحفظها كلها، وأعلم أنها موضوعة؛ حتى لا يجيء إنسان، فيجعل بدل (أبان) (ثابتاً)، ويرويه (عن معمر، عن ثابت، عن أنس)؛ فأقول له: كذبت؛ إنما هي (أبان لا ثابت)”([37]). “فأبان ضعيف وثابت ثقة وهما قرينان يرويان عن أنس، ويحتمل أن يُخطئ بعض من روى عنهما فيقلب إسناد حديث أبان ليجعله من رواية ثابت عن أنس، فالاحتياط أن يحصر الناقد روايات أبان عن أنس؛ فلربما تفرد راوي برواية عن ثابت لا يرويها عنه الثقات، ولربما كان صوابها أبان عن أنس، فهذه مادة جيدة للناقد قد يحتاجها في نقده”([38]).
مراتب الرواة في سلم الجرح والتعديل على ذلك هم: الثقات والرواة الصدوقون الذين لا يحتج بهم إذا انفردوا بأحاديث الأحكام والحلال والحرام، والرواة الضعفاء الذين لا يقبل حديثهم إلا بأمر يعضده. والرواة المتروكون الذين لا يكتب حديثهم إلا للمعرفة ولا تنفع روايتهم في التقوية.
ضوابط المتكلمين في الرجال (النقاد)
إن الكلام في الرواة يحتاج إلى ورع وتقوى من الناقد، وبراءة من الهوى والميل، وقدرة على التمييز بين الحق والباطل([39]).
اعتمد النقاد على المؤرخين الذين وثقوا التواريخ وهو ما عُرف بعلم التراجم([40])، كما امتلكوا فطنة وخبرة واسعة، ووعيهم النقدي جعلهم ألا يهملوا شيئاً من باب جمع أكبر قدر ممكن من الوثائق.
أما طريقة معرفة هذه الصفات فمن خلال الكتب المصنفة مثل: ذِكر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي. المتكلمون في الرجال للسخاوي. التاريخ لأبي زرعة الدمشقي. العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل. أو من خلال ترجمة الراوي وما في ترجمته من وصف له بالحفظ والإمامة والنقد، مثل الطبقات الكبرى لابن سعد وغيرها الكثير.
قال أبو حاتم الرازي (ت: 277ه) “لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم: أمناء يحفظون آثار نبيهم وأنساب سلفهم إلا في هذه الأمة، فقال له رجل: يا أبا حاتم، ربما رووا حديثاً لا أصل له ولا يصح، فقال أبو حاتم: علماؤهم يعرفون الصحيح والسقيم فروايتهم ذلك (أي الحديث الواهي) للمعرفة، ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها”([41]).
وقال أبو الوليد الباجي: “وقد يكون الحديث يرويه الثقة عن الثقة ولا يكون صحيحاً؛ لعلة دخلته من جهة غلط الثقة فيه، وهذه الوجوه كلها لا يعرفها إلا من كان من أهل العلم بهذا الشأن، وتتبع طرق الحديث، واختلاف الرواة فيه، وعرف الأسماء والكنى، ومن فاتته الرواية عن من عاصره ومن لم تفته الرواية عنه، ومن كان من شأنه التدليس ومن لم يكن ذاك من شأنه”([42]).
وقد كان منهج المتأخرين من النقاد في معرفة الضابطين من الرواة في تتبع الناقد لطرائق معرفة العدالة نفسها وهي: الاستفاضة والتنصيص والتوثيق الضمني. ووسائله في ذلك كانت: قواعد النقد وفقه علوم الحديث، جمع الروايات، ودراسة الأسانيد.
كما تتبع النقاد المتأخرون أحكام الأوائل لدقة فهمهم. قال الحافظ ابن حجر (ت: 852ه): “فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم ‑بتعليله‑ فالأولى اتباعه على ذلك، كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه”([43]). ويقول: “بهذا التقرير يتبين: عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم؛ بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه”([44]).
الشروط اللازم توفرها في الناقد إذن هي:
-حمله للموهبة النقدية وملكة التفكير الناقد والمتمثلة في القدرة على إدراك ما خفي في معرض التماثل أو الاختلاف في مسألة المراد نقدها.
-توفر الخبرة والممارسة الطويلة للعلم أو الفن المراد نقده في موضوع ما.
المبحث الرابع: مهارات علم الجرح والتعديل وكيفية استعمالها في التفكير الناقد
بما أن منهج المحدثين النقدي يرتكز إلى أسس فطرية بشرية موجودة لدى جميع البشر فينبغي على كل عاقل مسلم أن يمتلك هذه الأسس ويطبقها في مجالاته.
فقبل الحكم على أية رواية أو نقدها عمل العلماء النقاد بمنهجية الاستقراء التام وتتبع الجزئيات والرصد الكامل للرواة والروايات وللاتفاقات والاختلافات والموازنة والمقارنة وجمع القرائن، ثم تناقلوا الأحكام كما تناقلوا الروايات والأسانيد لحفظها أو للإضافة عليها أو مناقشتها. وهذا كله كان دافعه حفظ السنة ونشرها.
فكانت منهجية الاستقراء التام المتبعة في المنهج النقدي الحديثي تسير وفقاً للخطوات التفكيرية الناقدة الآتية:
1. استقراء طرق الحديث الواحد قال ابن معين: “لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه”([45]).
2. استقراء الأحاديث الواردة في الباب ورصد الاختلافات والاتفاقات فيها، قال علي بن المديني “الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه”([46]).
3. استقراء روايات الراوي الواحد؛ لمعرفة أهمية رواياته ومقدارها وموافقاته ومخالفاته وأخطائه قال أبو حاتم ابن حبان: “قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجوداً، وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيراً، فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفى عن أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات، فالتزقت تلك الموضوعات به”([47]).
4. استقراء أحاديث راو عن شيخ معين من شيوخه لكي لا يزاد فيها ما ليس منها.
5. استقراء أحاديث المتروكين كي تُعرف أحاديثهم بهم لئلا يخطئ راو فيرويها عن ثقة فتمر على بعض فيغتر بها.
6. استقراء الرواة فأحصوا عن فلان وشيوخ فلان وكم يروي فلان عن فلان.
وقد استعانوا على تطبيق هذه المنهجية النقدية بأداتين: الرحلة في طلب الحديث([48])، والمذاكرة. قال الخليل بن أحمد: “ذاكر بعلمك تذكر ما عندك، وتستفد ما ليس عندك”([49]). وقال الحاكم رحمه الله (ت: 405ه): “إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث”([50]). ومما روي عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المذاكرة قوله: “تذاكروا الحديث فإنكم ألا تفعلوا يندرس”([51]). لكن هذه المذاكرة كانت مختصة بالتفكر في معنى الحديث وفقهه.
أما في عصر التابعين فأصبحت المذاكرة النظر فيمن روى الحديث من الصحابة والتابعين. وأتباع التابعين النظر في طرق رواية الحديث وضبط ألفاظ متنه وفقه الحديث ثم المرحلة التي تليها أصبحت في حصر الروايات المسندة ثم الموقوفة والمقطوعة وذلك لتكميل أدلة الباب ومقارنتها. ومن النتائج المترتبة على المذاكرة: ضبط الأحاديث، الاستقصاء في جمع طرقها، مقارنة الروايات، معرفة المشهور من الغريب، والصحيح من الضعيف، وضبط الرواة، وما يتعلق بجرحهم وتعديلهم، وأصح الأسانيد، وأوهاها وعواليها وما تفرد به راو، أو أهل بلد دون سائر البلاد…
وفي عصر تغلّب القوى الصلبة والناعمة، وتوحّش السلطات السياسية، والتكالب على المال والشهوات، والجهر بالخيانات والعمالات، نلقى أنفسنا أمام افتقاد شديد لعصرِ الرجال، واغتراب بغيض عن الأخلاق والقيم الفاضلة، وغيابٍ للتفكير الناقد وإهمالٍ ظاهر ومعلن لعلوم ومناهج عقلية إسلامية دقيقة كان لها مجدها بين العلوم والمناهج وهي ضرورية لجعل عقل المسلم قادراً على التمتع بدرجات عالية من الضبط والدقة والوعي والتمحيص لإعداده وتربيته على مواجهة التحديات الجمة، والمتجلية في التبعية الفكرية والحالة المزرية من الوهن والضعف التي تكاد تكون مهلكة الأمة.
الخاتمة والتوصيات
الحمد لله أولاً وآخراً، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين:
بعد الوقوف على تكوّن المنهج النقدي الحديثي وتفاصيل هذا العلم وقواعده، وبعد البحث في علم الجرح والتعديل كواحد من أهم العلوم المنهجية النقدية التي جاء بها المسلمون وكنموذج على إعمال التفكير الناقد في العلوم الإسلامية، يمكن أن نستخلص الآتي:
إن الأمة الإسلامية اليوم في أمس الحاجة إلى تفعيل هذه المنهجية النقدية الدقيقة وإنزالها على مجالات الحياة اليومية؛ العملية والعلمية وحتى في الحياة اليومية العادية، واستثمار كل الطاقات والقدرات والمنهجيات الدقيقة للعقل التي وهبنا الله إياه والتي تندرج أصلاً ضمن مقاصد الشريعة المتمثلة بحفظ الدين والعقل، حتى ندفع عنها خطر تسلل مناهج غربية غريبة عنها، وننهض بأمة داهمتها الأخطار من كل حدب وصوب حتى باتت تُؤتى من داخلها.
وعليه نوصي بالنقاط الآتية:
- لعل من الأهمية بمكان عقد ورشة يكون عنوانها العريض المناهج النقدية في العلوم الإسلامية، تجمع علماء الدين وعلماء الاجتماع وطلاب العلوم الإسلامية لتسليط الضوء على بعض المناهج النقدية الإسلامية والتعريف بها.
- تشجيع طلاب الدراسات العليا على البحث في هذا المجال وإعداد الرسائل العلمية والأبحاث الأكاديمية وخاصة في مجال علم الجرح والتعديل كواحد من أدق العلوم النقدية الإسلامية، وكمثال على إعمال التفكير الناقد لدى المسلمين.
- مدّ جسور التواصل العلمي والأكاديمي بين علماء الدين وعلماء الاجتماع والتربويين لتنمية مناهج تربوية دينية تُدرج فيها المنهجية النقدية الدقيقة للعلماء المسلمين وطرق تفعيلها في مجالات المسلم العلمية والعملية والفكرية.
- ويجب أن تكون من مخرجات هذا التواصل بين علماء الدين وعلماء الاجتماع والتربويين محاولة تطبيق المناهج النقدية ‑بما فيها منهجية علم الرجال‑ تطبيقاً عملياً فعالاً إيجابياً يطال المؤسسات الدينية والعلمية والإعلامية وغيرها.
بحث قُدم للتخرج من دبلوم الدراسات الإسلامية، جامعة طرابلس اللبنانية
1438- 1439هـ/ 2017 – 2018 م
[1] مقدمة ابن خلدون، أسباب الكذب في الأخبار.
[2] الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي.
[3] سنن أبي داوود، باب في الرفق. الراوي: سعد بن أبي وقاص، المحدث: الألباني، الصفحة أو الرقم: 4810، خلاصة حكم المحدث: صحيح. موقع الدرر السنية.
[4] صحيح مسلم، باب في بيان الإيمان بالله وشرائع الدين. الراوي، المحدث: السخاوي، المصدر: فتح المغيث، الصفحة أو الرقم: 2/347، خلاصة حكم المحدث: صحيح، التخريج: أخرجه مسلم في “مقدمة الصحيح” (5)، وأبو داود (4992)، وابن حبان (30) من حديث أبي هريرة. موقع الدرر السنية.
[5] صحيح مسلم، باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة. الراوي: المغيرة بن شعبة، المحدث: شعيب الأرناؤوط، المصدر: تخريج المسند لشعيب، الصفحة أو الرقم: 18240، خلاصة حكم المحدث: صحيح، التخريج: أخرجه مسلم في “المقدمة” (1/9)، والترمذي (2662)، وابن ماجه (41)، وأحمد (18240) واللفظ له. موقع الدرر السنية.
[6] الكفاية في علم الرواية، مجلد 1، ص 19.
7 رواه الترمذي بإسناد ضعيف، كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الإحسان والعفو، ج 4، ص 320.
[8] حديث صحيح أخرجه أبو داوود في السنن، باب فضل نشر العلم، رقم 3228.
[9] أخرجه البخاري، كتاب العلم، رقم 105. ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، رقم 1679.
[10] صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم 3302.
[11] حديث صحيح، سنن ابن ماجه، باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم 232. وأخرجه الترمذي في الجامع، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، رقم 2705.
[12] وهو حديث مقطوع. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، بيان علل المسند، تحقيق: محمود الطحان، مكتبة المعارف، مجلد 2، 1403/ 1989، ص 269.
[13] المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق: محمد عجاج الخطيب، دار الفكر/ بيروت، ط 3، 1404/ 1984.
[14] المصدر السابق، فصل القول في فضل من جمع بين الرواية والدراية.
[15] المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي/ بيروت، 9 مجلدات، ط 2، 1392، المقدمة.
[16] البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، رقم 1242.
[17] الكفاية في علم الرواية، البغدادي، باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال، دائرة المعارف العثمانية، 1357، ص 134.
[18] الجامع لأخلاق الراوي، البغدادي، مجلد 2، ص 212.
[19] المجروحين، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة/ بيروت، ج 1، 1412/ 1992، ص 25.
[20] الموقظة في علم مصطلح الحديث، الإمام الحافظ الذهبي (ت: 748ه)، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية/ حلب، ط 1، 1405، ص 84.
[21] هذه القاعدة هي قوام علم الجرح والتعديل، محور البحث في الفصل الثاني بإذن الله.
[22] الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: 327ه)، عدد المجلدات 9، المجلد 2، دائرة المعارف العثمانية، باب بيان صفة من يتحمل الرواية في الأحكام والسنن عنه وباب بيان صفة من لا يحتمل الرواية في الأحكام والسنن عنه.
[23] مصطلح التاريخ، أسد رستم، مركز تراث للبحوث والدراسات، ط 1، 1436/ 2015، ص 48.
[24] المنهج النقدي عند المحدثين، عبد الرحمن السلمي، مركز نماء للبحوث والدراسات/ بيروت – الرياض، ط 1، 2014، ص 39.
[25] المرجع السابق، ص 93.
[26] علم الجرح والتعديل، عبد المنعم سيد نجم، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السنة 12، العدد الأول، 1400ه، ص 45- 55.
[27] علوم الحديث، ابن الصلاح (ت: 643ه)، تحقيق وشرح نور الدين عتر، دار الفكر المعاصر/ بيروت، دار الفكر/ دمشق، دون طبعة، ص 11- 12.
[28] بتصرف عن السلمي، المنهج النقدي عند المحدثين، ص 98 وما بعدها.
[29] صحيح مسلم، بشرح الإمام النووي (ت: 676ه)، تقديم: د. وهبة الزحيلي، المقدمة، باب أن الإسناد من الدين، دار الخير، 1416/ 1996.
[30] ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، اعتنى به: أحمد عبد السلام الزعبي، المجلد الأول، بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط1، 1418/ 1997، ص 82.
[31] السابق، ص 83. ويقول: “والشريعة مبناها على تصديق الصادق وقبول خبره، وتكذيب الكاذب والتوقف في خبر الفاسق المتهم، فهي لا ترد حقاً ولا تقبل باطلاً”. ص 92.
[32] السابق، ج 1، ص 96.
[33] مقدمة ابن الصلاح، ص 114- 115. وانظر كذلك الموقظة للذهبي، ص 87.
[34] ابن قيم الجوزية (ت: 751هـ) إعلام الموقعين عن رب العالمين، مجلد 1، ج 1، ص 10.
[35] انظر: النوع 28 من معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري، تحقيق: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية/ بيروت، ط 2، 1397/ 1977.
[36] مقدمة ابن الصلاح، ص 106.
[37] المجروحين لابن حبان، ج 1، 32.
[38] السلمي، ص 128.
[39] الموقظة للذهبي، ص 91.
[40] ونذكر من كتب المؤرخين: الطبقات لابن سعد (ت: 230 هـ)، والتاريخ الأوسط والكبير للبخاري (ت: 256هـ)، وتاريخ دمشق لأبي زرعة الدمشقي (ت: 281هـ)، والجرح والتعديل لأبي حاتم (327هـ)، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت: 463هـ)، وتهذيب الكمال للمزي (742هـ)، سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام وميزان الاعتدال للذهبي (748ه)، والحافظ ابن حجر (852ه) وغيرهم.
[41] تاريخ دمشق لابن عساكر (ت: 571ه)، ج 38، بيروت: دار الفكر، ص 30- 31.
[42] التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، أبو الوليد الباجي (ت:474ه)، تحقيق: أبو لبابة حسين، ج 1، دار اللواء للنشر والتوزيع/ الرياض، ط 1، 1406/ 1986، ص 297.
[43] النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: ربيع بن هادي عمير، النوع الثامن عشر، معرفة العلل، ج 2، الجامعة الإسلامية/ المدينة المنورة، ط 1، 1404/ 1948، ص 711.
[44] المصدر السابق، ج 2، ص 726.
[45] الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي، ج 2، ص 212.
[46] المعطيات السابقة.
[47] المجروحين لابن حبان، ج 2، ص 12.
[48] الرحلة في طلب الحديث للبغدادي، تحقيق: نور الدين عتر، دار الكتب العلمية، ط 1، 1395/ 1975، انظر ص 16- 17.
[49] فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي، السخاوي (ت: 902ه)، تحقيق: علي حسين علي، ج 3، دار الإمام الطبري، ط 2، 1412/ 1992، ص 317.
[50] معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري، النوع التاسع عشر: معرفة الصحيح والسقيم.
[51] أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب العلم، أما حديث علي، حديث رقم 296.
المصادر والمراجع
-إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، اعتنى به: أحمد عبد السلام الزعبي، المجلد الأول، بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط 1، 1418/ 1997.
-تاريخ دمشق، ابن عساكر، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دون طبعة، 1415/ 1995.
-التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، أبو الوليد الباجي (ت:474ه)، تحقيق: أبو لبابة حسين، ج 1، دار اللواء للنشر والتوزيع/ الرياض، ط 1، 1406/ 1986.
-الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، تحقيق: محمود الطحان، مكتبة المعارف، 1403/ 1989.
-الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، عدد المجلدات 9، دائرة المعارف العثمانية، دون طبعة، دون تاريخ.
-الرحلة في طلب الحديث للبغدادي، تحقيق: نور الدين عتر، دار الكتب العلمية، ط 1، 1395/ 1975.
-علم الجرح والتعديل، عبد المنعم سيد نجم، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السنة 12، العدد الأول، 1400ه.
-علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق وشرح نور الدين عتر، دار الفكر المعاصر/ بيروت، دار الفكر/ دمشق، دون طبعة، دون تاريخ.
-فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي، السخاوي (ت: 902ه)، تحقيق: علي حسين علي، ج 3، دار الإمام الطبري، ط 2، 1412/ 1992.
-الكفاية في علم الرواية، البغدادي، باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال، دائرة المعارف العثمانية، 1357.
-المجروحين، ابن حبان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة/ بيروت، ج 1، 1412/ 1992.
-المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق: محمد عجاج الخطيب، دار الفكر/ بيروت، ط 3، 1404/ 1984.
-مصطلح التاريخ، أسد رستم، مركز تراث للبحوث والدراسات، ط 1، 1436/ 2015.
-معرفة علوم الحديث، الحاكم النيسابوري، تحقيق: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية/ بيروت، ط 2، 1397/ 1977.
-الموقظة في علم مصطلح الحديث، الإمام الحافظ الذهبي، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية/ حلب، ط 1، 1405.
-المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية، عبد الرحمن بن نويفع فالح السلمي، مركز نماء للبحوث والدراسات/ بيروت – الرياض، ط 1، 2014.
-النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: ربيع بن هادي عمير، النوع الثامن عشر، معرفة العلل، ج 2، الجامعة الإسلامية/ المدينة المنورة، ط 1، 1404/ 1948.
مراجع إضافية مهمة مقترحة
-منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر.
-منهج النقد عند المحدثين، مصطفى الأعظمي.
-نظرية نقد الرجال، عماد الدين رشيد.